صلاح شعيب: القصر الجمهوري هو المصنع الحقيقي لإنتاج الإرهاب الديني
لم يبدأ التطرف الفكري والديني ضد الآخر مع تصريحات الداعشي الجزولي ولن ينتهي الأمر به. فكثيرا ما ننسى أن سلطة الإسلاميين قد سمدت التربة…
صلاح شعيب
لم يبدأ التطرف الفكري والديني ضد الآخر مع تصريحات الداعشي الجزولي ولن ينتهي الأمر به. فكثيرا ما ننسى أن سلطة الإسلاميين قد سمدت التربة لهذا التطرف حين انقضت على السلطة، وفرضت نظاما مستبدا للحكم، يسيره البشير أثناء وجود الترابي وبعده بالقمع الجسدي والمعنوي كيفما شاءا. وإذا استتثنينا الذين يناقشون جذور التطرف بناءً على تخريجات الجزولي الأخيرة فإن الذين يهاجمونه، وكذا يعنفون الطيب مصطفى، هذه الأيام بضراوة إنما بحاجة أيضا إلى التركيز الدائم لطعن الفيل الذي يبرطع في حدائق البلاد. والفيل الإرهابي هو من يدير القصر، ويعقد الصفقات في جنح الظلام مع الإرهابيين المحليين، والإقليميين، والدوليين. هذا هو الموضوع يا سادة وتلك هي المنصة التي يجب أن تصوبوا نحوها. ولقد سئمنا كتابات للمعارضة تسعى إلى شخصنة القضية مع الخال الرئاسي، أو ممثل داعش في الخرطوم دون أن تنفذ مباشرة لمخاطبة البيئة التي أنتجتهما وتفنيد مزاعمهما الجهلولة. فلئن تعلقت االظروف التي أملت سطوع نجم الجزولي ثانية باستخدامه ككرت سلطوي في المعركة الدولية تعلقت كذلك ببنية وعي متطرفة ونشطة مهدت لهذا السبيل الذي سار فيه. وهذه البيئة تحتاج إلى مستحقات ما تزال النخبة تغفلها وتلعن سنسفيل ضمور المعارضة بينما هي في صالوناتها الوثيرة تقيم الأنس المترف حول ما وصلت إليه البلاد في ظل تمدد التطرف في السودان. وماذا يا ترى ننتظر من تقاعس الآلاف من حملة الشهادات العليا عن خدمة الوطن بالرأي السديد، والتضحية في سبيله، غير تمدد الجزولي والتيارات التكفيرية الناتئة والمستترة؟. وكم هم الذين يخرجون للتعبير في الفضاء العام من الأجيال التي تخرجت في الجامعات عند الستينات، والسبعينات، والثمانينات.؟!
إن الأستاذة شمائل صاحبة القلم المثقف امتلكت الجرأة لطعن فيل البيئة من جذوره، ولذلك وضعها هذان الشخصان المتطرفان في مرمى نيرانهما. فكل ما قالته الزميلة الشجاعة هو أنها شككت بحيثياتها في التدين الشكلاني الذي صار سمة متصلة بحيوات الإسلاميين. وهذه حقيقة ساطعة كالشمس ولا تحتاج إلى مكابرات غليظة. فما أعان الله الإسلاميين الحاكمين على تنزيل مجهودات أسلمة زائفة لثلاثة عقود على الأرض، ولا أبانوا نموذجا للمسلم الذي يحتذى بعلمه، وخلقه، وصدقه، وزهده في التسلط، وعفافه عند المغنم. وعوضا عن ذلك أصبح غالب الإسلامويين يرضعون من ثدي البقرة السودانية الحلوب لمدى هذه العقود من الزمان. ومنتهى الموضوعية هو القول إنه في غياب معيارية للعدل أصبح فقيرهم غنيا، ومغمورهم في أيما محفل إبداعي رمزا وطنيا كاذبا، ومن كان يمتلك زوجة ضاعفها مثنى، وثلاث، وبعضهم رباع. ومن كانت خلفيته أنه لا يملك أرضا حتى في قريته القصية تحول إلى حائز على آلاف الأفدنة في مديرية الخرطوم. وذلك الذي كان مستدانا لصاحب الإيجار، واللبن، والجزارة، أصبح يملك بواخر نفط تجوب البحار. أما الذي كان يرعى ميراث أسرته من الحواشات فقد أضحى مُصدرا لأطنان اللحوم إلى دول الخليج. ومن عرف أن مجموع مؤهلاته هي أنه فني لا سلكي، لا غير، فإنه صار مالكا للبنوك، والشركات، وربما وزيرا للخارجية. وبعضهم امتلكوا أحزابا لخاصتهم يبتزون بها زملائهم في الحكومة، ومؤسسات إعلامية تخدم هذا الابتزاز الملحوظ. وهكذا تحول المشروع الخادم لشريعة الله، وعباده، إلى مشروع استثماري ضخم لعضوية الحركة الإسلاموية التي ما تزال توظف الآي الكريم، والسنة النبوية، ومأثورات الإسلام لخداع الناس، بينما المسغبة والأمراض والهروب من البلاد تطبق على أحوال فقراء مسلمي السودان، وغير المسلمين، والذين كانوا أولى بالرعاية إن كان موضوع العدل على هدى الإسلام قد حمل الجماعة الإسلاموية للوصول إلى السلطة. بل إن الأنكأ وأمر هو أن الإسلاميين الآن يفرضون الضرائب، والأتاوات على فقراء السودان حتى يحافظوا على وضعيتهم الاجتماعية المترفهة. وإذا كان هناك من به ذرة من إسلام لما رضي أن يعيش على عرق ستات الشاي، والدرداقات، والذين يفترشون الأرض للمتاجرة في الليمون. ما أعظم السقوط؟!
-2-
وفي كل هذا لا يخجل هؤلاء الإخوة الإسلامويون من إقامة نوعين من العدل. عدل يأخذ الاستبداد وسيلة نافذة على كل من لا ينتمي إليهم لاعتقاله، ومحاكمته بالسجن، والغرامة المالية، والنفي غير المباشر. وعدل آخر خاص "يتحللون" به من فسادهم المالي. ليس ذلك فحسب وإنما تتفتق الذهنية المتأسلمة لفرض أماكن راقية للعبادة مقفولة لهم وتميزهم عن السواد الأعظم، إذ يخطب فيها من يشرعن لهم الأفك، والآثام، حتى يمنحوا إياه الوظيفة والامتيازات. أما أمن الدولة الذي يبتلع كل الميزانية فهو إنما ليوطن استبداد عضوية الحركة الإسلامية لا حماية سلام البلاد. وبهذا الأمن يعذبون معارضيهم، ومن ناحية أخرى يستوعبون عضويتهم ليكون مصدرا لرزقهم، وموئلا لاستثمارات شركاتهم المتخفية بأسماء وهمية.
من متن هذه البيئة خرج الطيب مصطفى للناس ناشرا، وكاتبا، ورئيسا لحزب، ومالكا لمؤسسات إعلامية، وجمعيات خيرية يتفاخر بأنها قدمت مساعدات للمساكين. ولكن السؤال هل كان يستطيع هذا الخال أن يجمع مالا ليستفيض إن كانت البلاد تدار بكل شفافية، ومؤسسية، وهو الذي بحكم قرابته لفيل القصر يجد الطريق سالكا لكل استثمار أراد؟. وأيضا داخل هذه البيئة الخربة التي لا تقوم على عدل، ومساواة، تفرهد الداعشيون وخرج زعيمهم للناس ليؤسس نهج التفكير بحق أبناء وبنات الوطن. ولا يتوانى من دعم خطة التنظيم الإرهابي الذي يعتمد على العنف، والقتل، وحرق الأسرى، وصلبهم، وإقامة سوق النخاسة، وسيلة لإعادة ما يسمونه مجد الخلافة الإسلامية.
إننا لا نعتقد أن البيانات التي تستهدف الجزولي في شخصه ستفيدنا في مقاومة هذا التطرف الفكري والديني المؤسس على خلفية ضرورات وجود النظام التي جذرها كثيرون. وهب أن الجزولي مات فجأة هل ستخلو الساحة من مكفرين جدد وتنتهي من ثم الزوبعة الحادثة الآن حول مساع ٍ متصورة لاستتابة الصحفيين، والكتاب، وتهديد العلمانيين. فالإرهاب الحقيقي الذي يجب أن يواجه بالتفنيد الفكري هو الذي يرعاه فيل القصر، ولا قيمة للتركيز فقط على الظلال التي يخلقها هنا وهناك. ولعل أولئك الذي يريدون التغيير ينبغي عليهم، عبر وسيلة المقاومة، إزاحة البيئة التي وطنت هذا الفكر الداعشي، وسيطرت على عقول الشباب، وفوجتهم للخارج لا لتحصيل العلم، وإنما لارتكاب العنف.
-3-
الحقيقة هي أن العنف الفكري ليس هو الحل بل إنه لا يولد إلا العنف المقابل. ولا يحلمن أحد أن هذا الطريق سيقود البلاد إلى تقنين الاستبداد، وفرض اتجاهات فكرية بعينها، وقمع أخرى. فتجربة الإنقاذ أكدت أن عنفها لم يولد إلا عنف أكبر، وبالتالي وصلت البلاد إلى هذا الدرك الأسفل من التخلف عن ركب الدول المتقدمة. بل إنها صارت أدعى لفقدان تماسكها الوطني حتى بعد انفصال الجنوب، بينما ما تزال كل مؤشرات القراءات الحالية للأوضاع السياسية، والاقتصادية، والأمنية، ترشحها للانفجار تحت أي لحظة. على أنه ليس هناك من سبيل للخروج من أزمة الحكم الإسلاموي إلا سبيل ثورة كل العقلاء ضده بالشكل الذي يماثل فداحة الأزمة. وأرجو ألا يحاضرنا أحد أن الأزمة تبدأ من غياب المعارضة. والسؤال هو ما هي هذه المعارضة المطلوب منها التصدي للتطرف الديني، قبل تحريك الشارع للانتفاض ضد النظام وإسقاطه، أهي الأحزاب المركزية المعروفة أم سائر الراشدين الذين يملكون القدرة على التعبير ضد الخطأ في زمان غدا فيه النشر أسهل من الحصول على الماء؟.
إن الشئ المؤسف أن هناك تقاعسا كبيرا من النخب المؤهلة علميا، وعمليا، في مواجهة التحديات الكبيرة التي تجابه البلاد، والتي من ضمنها العنف الفكري. وإذا أعفينا النخب التي تقطن في الداخل لشدة الحصار الذي يحيط بها من كل حدب وصوب فإننا لا نعفي الآلاف من غير الناشطين في السياسة، ومنظمات المجتمع المدني، والميديا الحديثة، والذين يفضلون الحيدة في التعبير، إن لم يكن السكوت، والبعد عن التورط في تسجيل المواقف الوطنية الشجاعة مع أو ضد. ولا نعدو الحقيقة إن قلنا إن هذه النخبة تمثل الغالبية بالنظر إلى النخب التي تتعاطى مع الشأن العام. وهذه النخبة الصامتة تتنوع تخصصاتها العملية، والوظيفية، في الخارج دون أن تدلو بدلوها عبر بيانات مهنية يماثل الدور الذي قام به ستة من حائزي جائزة نوبل، أو وولي شوينكا الحائز على جائزة نوبل أيضا لوحده، في تسجيل مواقفهم تجاه بعض القضايا السودانية. ولكل هذا نعتقد أن الأحزاب التقليدية، والقطاعات التي نجملها ضمن تعريف المعارضة، ليست هي مسؤولة وحدها عن إحداث التغيير إن لم تتغذ بروافد النخب السودانية الصامتة لدعمها في منازلة نظام التطرف الديني، والاستبداد السياسي، والاستثمار في إضعاف المكونات القومية.





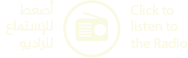
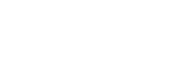




 and then
and then