التجاني عبد القادر حامد: مستقبل اتفاق العسكر وقحت ..
مشهد الأعداد “المليونية التي خرجت في مسيرة الثلاثين من يونيو 2019 يؤكد ما بات مؤكدا: أن شعلة الثورة السودانية لم تخمد. أما إن قُدر لهذا الحراك أن يُترجم …
 د. التجاني عبدالقادر(وكالات)
د. التجاني عبدالقادر(وكالات)





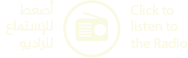
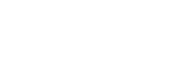




 and then
and then