القيادة: أهم دروس الثورة السودانية ..
مضت سنة على انطلاق الثورة السودانية، وسودان اليوم لا يشبه سودان البارحة. يحتفل الشعب السوداني اليوم، ومعه كل الأحرار في العالم العربي، بإسقاط نظام الرئيس الطاغية عمر البشير، بعد أن حكم أكبر بلد أفريقي ثلاثين سنة،

بقلم: د. عائشة البصري
مضت سنة على انطلاق الثورة السودانية، وسودان اليوم لا يشبه سودان البارحة. يحتفل الشعب السوداني اليوم، ومعه كل الأحرار في العالم العربي، بإسقاط نظام الرئيس الطاغية عمر البشير، بعد أن حكم أكبر بلد أفريقي ثلاثين سنة، دمّر فيها البلاد وقتل وشرّد العباد وفرّط في وحدة التراب السوداني. في الذكرى الأولى للثورة، يحتفل السودانيون كذلك بإصدار قانون "تفكيك نظام الإنقاذ"، وحظر حزب المؤتمر الوطني (الإسلامي) الذي استخدم واجهة للبشير، ليمارس الاضطهاد والظلم والقهر تحت غطاء ديني.
وضع القانون الجديد لجنة تنفيذية لحل حزب البشير، ومصادرة أمواله وأصوله وممتلكاته، وتعليق النشاط السياسي لرموزه، وتفكيك كل البنية السياسية وشبكة العلاقات التي نسجها النظام، مثلما يبسط الأخطبوط أذرعه الحلزونية. وألغت السلطة الانتقالية قانوناً آخر، كان يستهدف المرأة السودانية، ويحدّ من حريتها في اللباس والتنقل والعمل والدراسة، ويعاقب المخالفات منهن بالسجن والجَلد أمام الملأ. وتمثل هذه القوانين إنجازاً مهماً، ما كان له أن يتحقق لولا الدور الطلائعي الذي اضطلع به تجمع المهنيين السودانيين، بما في ذلك تنسيق وتدبير وقيادة الاحتجاجات منذ اندلاعها. ويضم التجمع نقابات مهنية كانت قد أعلنت عن تشكيلها للدفاع عن حقوق المهنيين، على الرغم من مناهضة النظام لها. وما إن ازداد زخم الثورة في مطلع هذه السنة، حتى لحقت الركب قوى مدنية وأحزاب سياسية وحركات مسلحة معارضة للنظام، وشكلت، مع تجمع المهنيين، تحالفاً كبيراً بات يعرف بقوى الحرية والتغيير، بعد أن وقعت على وثيقة باسم "إعلان الحرية والتغيير". هكذا تحولت الانتفاضة الشعبية التلقائية إلى مشروع ثورةٍ تهدف إلى الخلاص من دكتاتورية نظام الإنقاذ، وإحداث تغييرات جذرية في البنى المؤسسية للدولة والمجتمع، وفقاً لمبادئ وقيم ديمقراطية.
زحف الثوار، في شهر إبريل/ نيسان الماضي، نحو مقرّ قيادة الجيش، واعتصموا أمامه إلى أن أصبحت الثورة تهدّد وجود النظام برمته، ولكن الجميع فوجئوا بمسرحية انقلابٍ فُرض من خلاله مجلس عسكري، تكون من متهمين بارتكاب جرائم حرب وعملاء السعودية والإمارات، وفي مقدمتهم محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد مليشيات مرتزقة متهمة دولياً بجرائم الإبادة وفظائع أخرى في إقليم دارفور، والجنرال عبد الفتاح البرهان، أحد كبار المشرفين على تنفيذ جرائم نظام البشير.
لم تكن قيادة الثورة مستعدة لسيناريو سطوة عساكر البشير على الثورة بعد إبريل/ نيسان، إذ لم تكن لديها سلطة قادرة على البدء فوراً في تطبيق برنامج الإعلان الثوري، عبر إجبار المجلس العسكري على التنحّي، بعد أن نصّب نفسه قائداً فعلياً للبلاد، فعلى الرغم من مطالبتها بتنحّي المجلس، لكونه امتداداً للنظام، استجابت، في الأخير، لدعوته إلى الحوار والتفاوض، بعد أن كشّر العساكر عن أنيابهم، وأغرقوا العاصمة بمليشيات وجنود بلا رحمة، فأردوا مئات من الشهداء في ربوع البلاد، وأبانوا عن استعدادهم لارتكاب مزيد من المجازر بعد مجزرة فضّ الاعتصام في يونيو/ حزيران الماضي.
ولحقن دماء الشعب، فضّلت قوى الحرية والتغيير أن تسلك منحىً واقعياً، يستثني الاصطدام بجنرالات الإبادة، ويراهن على التغيير السلمي التدريجي والتراكمي، عوض التغيير الجذري والفوري، خصوصاً وقد توفقت في اختيار رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك الذي يحظى باحترام وتأييد واسعين داخل البلاد وخارجها.
ما زالت الثورة السودانية في بداياتها، وتواجهها تحدياتٌ عصيبة، في ظل تقاسم السلطة مع كبار المجرمين وأعداء السلام والديمقراطية والعدالة، إلا أن قرار تفكيك حزب المؤتمر الوطني خطوة مهمة في مسيرة التغيير، ويمهد لتحوّل حقيقي نحو ما بعد "نظام الإنقاذ". ويشكّل تقاسم المدنيين السلطة مع العساكر، في حد ذاته، تغييراً جوهرياً في الممارسة السياسية، وبنية مراكز القرار التي كان يحتكرها الحزب البائد. وعليه، فإن أهم عبرة يمكن للشعوب المنتفضة في الجزائر والعراق ولبنان استخلاصها من الثورة السودانية تكمن في ضرورة وجود طليعة ثورية واعية جداً، تنسّق احتجاجات الشعب، وتوحد الصفوف والمواقف المتعارضة، وتحاور وتطرح البدائل الديمقراطية لإسقاط الأنظمة الفاسدة، وبشكل تدريجي إن اقتضى الأمر.
أمضى الثوار في الجزائر أزيد من أربعين أسبوعاً في مسلسل احتجاج لم يفرز نخبة تمثله وتتحدث باسمه، وتتحرك لتحقيق أهدافه عبر الحوار والضغط والتفاوض، وتقديم بدائل من شأنها أن تحول دون مناورات النظام لإعادة تدوير النخب الفاسدة نفسها. وفي ظل هذا الفراغ، يبدو أن النظام العسكري يحذو حذو دكتاتورية عبد الفتاح السيسي في مصر عبر فرضه "انتخابات العصابات"، وسط انقسام شعبي وقمع ينذر بالعودة بالبلاد إلى مربع عنف العشرية السوداء في تسعينيات القرن الماضي.
وفي العراق، لا مثيل لعزيمة الثوار وتضحياتهم وتحدّيهم لمليشيات القنص ودولة القمع، ولكن افتقادهم قيادة ثورية يشكل كارثة عظمى في ظل نظام شمولي دموي، يخدم أولاً مصالح إيران وأميركا وأعوانهما من العملاء العراقيين. ثم يبدو أنه ليست للمحتجين رؤية وخطة واضحة للتغيير، فبعضهم يهتف بالعلمانية والدولة المدنية وإلغاء الطائفية، في حين يكبّر ويهلل آخرون باسم مقتدى الصدر والسيستاني والمرجعية. وإن لم تولد من رحم الثورة العراقية نخبة قادرة على بلورة رؤيةٍ تعبّر عن مطالب الشعب، وتنسيق احتجاجه وإبعاده عن فخ الحرب الطائفية التي تهدّده، وطرح استراتيجية لإعادة تشكيل النظام السياسي على أساس المواطنة، فمن الصعب زعزعة نظام يحصد أرواح أبناء الشعب بجيشه ومليشياته، العراقية منها والإيرانية، وبتواطؤ سلطاته وبرلمانييه وأحزابه، وبمباركة مرجعيته وصمت المجتمع الدولي.
هذا هو الدرس الذي يبدو أن اللبنانيين قد استوعبوه بعد مرور بضعة أسابيع على بداية احتجاجهم، فقد نظّم المحتجون أنفسهم وشكّلوا هيئةً لتنسيق الثورة، تضم عشرات القوى والمجموعات المنخرطة في مشروع التغيير التي وضحت أهدافها، وحدّدت إطار عملها في وثيقة أصدرتها يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي. وبهذا يكون الثوار اللبنانيون قد أبطلوا أيضاً النظرة الخرافية التي ساهم الدبلوماسي البريطاني السابق، كارني روس، في إشاعتها عبر كتاب أصدره عام 2012 بعنوان "ثورة بدون قيادة". ففي بداية الربيع العربي، أُعجب روس بالمدّ الثوري الذي حرّك شعوب المنطقة، ومضى يزعم أن في وسع الناس العاديين أن يستغنوا عن وجود قيادات لحراكهم، ويستولوا على السلطة بمفردهم، ويغيروا السياسات في القرن الواحد والعشرين. ولكن مآل هذه الثورات في كل من سورية ومصر وليبيا واليمن أظهر أن روس قد أخطأ في تنظيره وتقديره لوعي الشعوب العربية، بل إن بداية نجاح الثورة نسبياً في كل من تونس والسودان يرجع بالأساس إلى وجود نخب ثورية تضمّ أحزاباً ونقاباتٍ وجمعياتٍ مدنية قادرة على الممارسة السياسية.
أما الثورة بلا قيادة، والتي ما زال يروّجها بعضهم، فهي جسد بلا رأس، ومجرد فوضى تستجلب الموت برصاص القناصة أو سيارة بدون سائق تسير بالبلاد حتماً نحو الهاوية.





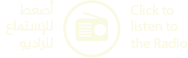
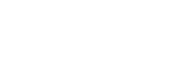




 and then
and then