مداخل لفهم العنصرية في المناهج التعليمية بالسودان
الكتابة حول موضوع العنصرية، هي من أكثر أنواع الكتابات صعوبة وإحراجاً في ذات الوقت، ذلك؛ لأن طبيعة الموضوع نفسها غير مستساغة أو مقبولة على جميع المستويات، فلا المستفيدين من الممارسة العنصرية أو ضحاياها بقادرين في معظم الأحوال على التعبير بصراحة كبيرة عن الموضوع وتفاصيله، فهو بالنسبة للطائفة الأولى أمر مخجل على أية حال، وبالنسبة للطائفة الثانية “مسكوت عنه” عند النظر إليه في سياق تحليل سيكولوجية القهر وعلاقاته
بقلم : التجاني الحاج عبدالرحمن
مقدمة:
الكتابة حول موضوع العنصرية، هي من أكثر أنواع الكتابات صعوبة وإحراجاً في ذات الوقت، ذلك؛ لأن طبيعة الموضوع نفسها غير مستساغة أو مقبولة على جميع المستويات، فلا المستفيدين من الممارسة العنصرية أو ضحاياها بقادرين في معظم الأحوال على التعبير بصراحة كبيرة عن الموضوع وتفاصيله، فهو بالنسبة للطائفة الأولى أمر مخجل على أية حال، وبالنسبة للطائفة الثانية “مسكوت عنه” عند النظر إليه في سياق تحليل سيكولوجية القهر وعلاقاته. أيضاً تأتي الصعوبة من جانب أنه وفي الوقت الحاضر، وبعد تطور الإنسانية الذي أصبحت فيه السلوكيات العنصرية مدانة، فقد أضحت مثل هذه الممارسات تنحو أكثر نحو الغموض وإلإلتباس والتخفي، بمعني؛أنها أصبحت تتجه أكثر فأكثرنحو”التضمين” بإستخدام التعبيرات غير المباشرة والمفردات الثانوية، أو تلك التي يشتق معني العنصرية بتحليلها وردها إلى مصادرها الأولية بدلاً من التعبيرات الصريحة. وبالتالي فإن ذلك يصعب من مهمة الباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
الورقة تحاول فهم مداخل العنصرية في المناهج التعليمية في السودان، وهو موضوع فيه الكثير من الصعوباتعندإقتفاء أثرهداخل المواد الدراسية ــ كما قلنا. ويزداد الأمر تعقيداً لأن التعامل هنا هو مع مناهج تعليمية تتسم بقدر من “العلمية”ــ إن جاز التعبير ــ خاصة في حقل مواد ليست جميعها وبطبيعتها قادرة على إدماج المفاهيم العنصرية داخلها مثال مواد العلوم الطبيعية والرياضيات. لذلك فقد أخذنا نماذج مواد مختلفة من مقررات الأساس وحاولنا تتبع ذلك من خلال تحليل النصوص والأمثلة الواردة في هذه المناهج ومحاولة رؤية المضامين العنصرية داخلها.
مفاهيم وتعريفات ضرورية:
(1) تعريف مصطلح العنصرية Racism:
تعرَّف العنصرية بشكل عام من خلال تعريف الانحياز والتمييز أو الإستبعاد المؤسس على التباينات الاجتماعية أو البيولوجية بين الناس. وفي أغلب الأحوال تأخذ هذه الانحيازات أو الإستبعادات شكل سلوك اجتماعي أو معتقدات أو نظام سياسي يعتبر أن التباينات الاجتماعية يمكن وضعها في تراتبيات موروثة في “أعلى” و “دون”، وهو ما يتطلب أن تُعامل هذه الأعراق والكيانات الاجتماعية بصورة مختلفة عن بعضها البعض. ويعتقد بعض الباحثين: “أن أي سلوك لفرد يمكن أن يكون متأثراً بتصنيف عرقي موروث بصرف النظر عمَّا إذا كان هذا السلوك مضر أو صالح”، وهو نوع من عمليات “التنميط “Stereotyping .وبالضرورة فإن أي عملية تنميط تؤدي إلى نوع من الدونية لهوية آخرين. ففي علم الاجتماع وعلم النفس بعض التعاريف تتضّمن مع ذلك أشكال الكراهية المصحوبة مع عملية التمييز.هناك وجهة نظر تقول إن العنصرية تُفهم فقط كــ ” انحياز + سلطة”، ذلك لأنه ومن دون الدعم والسند السياسي/الاقتصادي لن يكون للانحياز أو التمييز القائم على أساس العرق أو اللون أو العنصر كظاهرة اجتماعية أي معني أو تأثير كبير على المستوى الثقافي والمؤسسي. ومن ضمن الأسئلة الكثيرة حول تعريف ظاهرة العنصرية: مثلاً: هل بالإمكانضمان أن التمييز الغير متعمد، مثال وضع نماذج وتصوُّرات عن الآخرين مبنية على الأنماط العرقية أو السلالية، أو أن الأشكال الرمزية أو المؤسسية من التمييز مثال إعادة إنتاج التنميط العرقي من خلال وسائط الأعلام والحراك الاجتماعي ـ السياسي من خلال التراتبيات الاجتماعية ليس لديها مضمون عرقي سالب ؟
عموماً؛ يمكن تجريد تعريف العنصرية في التمييز القائم على العرق، السلالة واللون بحيث يضع فرد، كيان (ما) في اعلى سلم التراتبية الإجتماعية، وآخرون يندرجون في المراتب الأدني التي تليها (ثانية وثالثة..إلخ).
(2) فك الإشتباكات بين مفهومي العرق والسلالة Race and Ethnicity :
هنالك فرق ما بين “عرق” Race)) و “مجموعة سلالية” (Ethnicity)، وفي كثير من المقالات خاصة عند دراسة وتناول أنماط السلوكيات يخلط الناس مابين مصطلح العرق (Race) والتمييز القائم على أساسه وبين السلالة (Ethnicity) والتمييز القائم على أساسها، وهي ترد في كثير من المقولات بــ “الإثنية” مثال الدولة الإثنية أو الدولة ذات التوجاهات/السياسات الإثنية، فالإثنية ليست هي العرقية أو التمييز القائم على أساسها. هذا النوع من التداخل يُضعفالتوصيف الدقيق للممارسات والسلوكيات ذات الطابع التميزي أو الإستبعادي القائم على العرق. ومع لك؛ فإن وجهة نظر علم الاجتماع المعاصر ترى أن المصطلحين لديهما تاريخ طويل من التساوي في الاستخدام العامي،خاصة في علم الاجتماع القديم. وبالتالي فإن “العنصرية” والتمييز القائم على أساس العرق دائماً ما كان يستخدم لتوصيف التمييز القائم على أساس ثقافي بصرف النظر عما إذا كان التباينات هي عرقية أما لا. وبناءاً على ذلك، وفيما بعد، قامت الأمم المتحدة بوضع حد فاصل في تعريف العنصرية بشكل دقيق، ومضت باتجاه التفريق الكامل ما بين مصطلحي “تمييز عرقي” Racial Discrimination و “تمييز سلالي” Ethnic Discrimination ــ إن جاز التعبير في هذا المنحى ـــــ بعد أن ثبت أن ادعاء التفوق القائم على الاختلاف العرقي من الناحية العلمية غير صحيح، لا وبل مدان من الناحية الأخلاقية، وغير عادل أو منصف من الناحية الاجتماعية. لذلك لا يوجد تبرير للتمييز القائم على العرق من الناحية النظرية أو العملية في أي مكان كان.
(3) العنصرية المؤسسيةInstitutional Racism:
تُعرَّف “العنصرية المؤسسية” على أنها: “.. أي نظام من عدم المساواة القائمة على التمييز على أساس العرق، والتي تظهر في المؤسسات مثل الهيئات الحكومية، القطاع الخاص، المؤسسات التعليمية (المدارس والجامعات العامة أو الخاصة)”. أول من أدخل مصطلح “العنصرية المؤسسية”هم نشاطون فيما كان يُعرف بـ (“القوة السوداء)،والتي نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف القرن الماضي . وقد عاد مفهوم “العنصرية المؤسسية” للظهور مرة أخرى في الخطاب السياسي بنهايات 1990،وقدظل منذ ذلك الوقت وإلى اليوم، من أكثر المفاهيم عرضة للنقد العنيف وعدم القبول والرضى. هناك من يرى أن العنصرية المؤسسية مماسة عملية التفريق/التمييز أو إعطاء الأفضلية في الوصول إلى مصادر الخدمات، الفرص الإجتماعية. وعندما تصبح عملية التفريق/التفضيلهذه مدمجة في المؤسسات، تتحول بشكل تلقائي إلى سلوك عام وسائد من الصعوبة بمكان معالجته. وتبعاً لذلك تسود هذه العنصرية في المؤسسات العامة حكومية وغيرها، الشركات أو الهيئات الخاصة، مؤسسات التعليم العامة والخاصة، وتصبح سلوكاً غير مستساغ أو مقبول لكنه لا يلفت إنتباه الناس في كثير من الأحيان، ويتم ممارستهبواسطة الناس التقليدين القدامي أو أولئك القادمون الجدد.
الوجه الآخر في صعوبة إقتفاء العنصرية المؤسسية والتقليل من آثارها، هو أنه لا توجد هيئة إعتبارية محددة أو شخص بعينه في ممارسة هذا النوع من السلوكيمكن إعتباره هو المخطئ أو المدان بها بحيث يمكن الإشارة إليه مباشرة.وفي الغالب الأعم ما تصبح هذه الممارسات مضمنة داخل مؤسسات الدولة بمختلف أشكالها، وقد لا تحد منها القيود القانونية المدونة في هذه المؤسسات، بل عادةما تمارس على خلفية قوانين وأعراف غير مكتوبة يدركها جيداًمن هم داخل المجموعات التي تمارسها أو تلك المستفيدة منها، وتتمظهر كنمط سلوك جماعي لكل المجتمع سواء إن كان مقبولاً أم لا. أقرب نموذج لذلك هو الإختيارات التي تتم على أساس الخلفية العرقية/السلالية لقطاعات الخدمة المدنية في السودان والتي أحصاها الكتاب الأسود.
افترض بروفسور جيمس جونز ثلاثة أنواع من العنصرية: (1) العنصرية الشخصية أو الفردية (2) العنصرية الداخلية و (3) العنصرية المؤسسية. العنصرية الشخصية أو الفردية تتمثل في الإنحيازات العرقية الموروثة (إفتراض التميزُّ العرقي في سلوك والقائم على فرضية إنحطاط عرق الذات المقابلة). (2) العنصرية الداخلية، وهي أشكال التنميطات والتوُّجهات والإستبعادات التي يمارسها الأفراد أو الناس الذين تطبع سلوكهم وعقلياتهم توجهات عنصرية سالبة عن قدراتهم وقيمهم الموروثة مما ينتج عنه تدني في الثقة بالنفس والثقة في قبول الآخرين لهم. هذا النوع من العنصرية تعبر عن نفسها في التميز القائم على “بياض لون البشرة مقابل سوادها”، خلفية الأسماء، أو الرفض للتراث الثقافي..إلخ. وبالتالي فإن إستمرارية عملية التنميطالسالبة هذه، هي التي تغذي العنصرية المؤسسية (3) عموماً العنصرية المؤسسية يمكن تحديدها من خلال ظهور السياسات والممارسات الشوفينية المنظمة، والبنيات الإقتصادية والسياسية والتي تضع مجموعات الأقليات العرقية و السلالية في موقع النقيصة أو الدونية في مقابل مجموعات الأغلبية العرقية في مواقع التمييز. مثال لذلك كما كان حادثاً في الولايات المتحدة خاصة فيما يتعلق بالموارد المخصصة للمدارس العامة ونوعية المعلمين، والتي كانت دائماً مرتبطة بالأوضاع الإقتصادية للأحياء والمدن مثال أحياءالأغنياء ــ والذين هم في الغالب من البيض ـــ والذين كانت مدارسهم وخدماتهم تحصل على أفضل المعلمين أو الأطباء والموارد المالية الأعلي، في مقابل أحياء الفقراء ــ والذين هم غالباَ من السودــ والذين كانوا يحصلون على نسب أقل في خدمات التعليم من حيث الموارد، ومعلمين أدني كفاءة.أيضاً السياسات التمويلية في الإسكان. نوع أخر من العنصرية المؤسسية وهي أن الإنتماء للأجهزة الأمنية كالبوليس تم تنميطه على أنه مؤسسة لا ينتمي إليها إلا السود وهو نوع من التنميط يشيرإلى إرتباط السودا بالعنف.
المرور عبر هذه المفاهيم والتعاريف كان ضرورياً ولابد منه لما نحن بصدده، وهو عملية إقتفاء العنصرية في المناهج التعليمية. وبالتالي فإن هذا النوع أو النمط من أشكال التمظهر العنصري داخل المناهج التعليمية يقع ضمن نطاق مفهوم أو تعريف “العنصرية المؤسسية”، طالما أن العملية التعليمية هي شكل مؤسسي، وجزء لا يتجزاء من مؤسسات الدولة، أو هذا ما يجب أن تكون عليه. وكما ذكرت في البداية أن إقتفاء مثل هذا الأثر من الصعوبة بمكان، فإننا نواجه نفس الصعوبة خلال عملية بحثنا الأنز الطريف في الأمر، هو أنني وأثناء عملية البحث عن هذه الآثار في المناهج السودانية حاولت الإستعانة بالشبكة العنكبوتية (الإنترنت) لجمع المعلومات أو أي دراسات حول الموضوع، وكم كانت دهشتي عظيمة عندما لم أجد أي مراجع أو كتابات متوافرة باللغة العربية عن العنصرية بشكل عام أو العنصرية في المناهج التعليمية العربية أو السودانية، فكل الكتابات أو المقالات التي ظهرت مدونة باللغة العربية في الشبكة العنكبوتية، كانت عن العنصرية في إسرائيل أو المناهج التعليمية الإسرائيلية، ولم أجد مقالاً واحداً يتحدث عنها في الدول العربية أو السودان، وهو أمر جدير بالإشارة إليه.عكس حالة البحث باللغة الإنجليزية حيث هناك كتابات عن العنصرية في الدول العربية كتبها غير عرب وغير سودانيين، وبطبيعة الحال تظل مثل هذه الكتابات ومهما كانت درجة مصداقيتها مدانة أو موصوفة بالإستشراق على أقل تقدير.
تحليل نماذج من مناهج الأساس بالسودان:
على أي حال سأحاول إقتفاء هذا الأثر من خلال إختيارات لنماذج من كتب دراسية من مرحلة الأساس بالسودان وتحليلها إن كانت ذات محتوي عنصري أم لا.
نموذج (1): كتاب المنهل في اللغة العربية
الدرس الثالث (صفحة 7 ـ 8): المسجد المدرسة الأولي:
يذكر الدرس:
“تذَّكر أيها التلميذ النجيب أن ــ أول عمل قام به الرسول صلي الله عليه وسلم ــ بعد هجرته من مكة وإستقراره بالمدينة (….) هكذا كان المسجد في بلاد المسلمين، مكاناً للصلاة، وساحة للعبادة ومدرسة للعلم..” (مرفقة خريطة تبين بعض مواقع المساجد القديمة بالسودان وهي سواكن، طوكر دنقلا العجوز وسنار). ويذكر النموذج أيضاً: : “… وبلاد السودان ــ أيها التلميذ النجيب ــ من البلاد التي عرفت الإسلام من قديم الزمان؛ فقد دخل المسلمون الجزء الشمالي منه في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. ففي عهد خلافته قاد عبدالله بن أبي السرح جيوش المسلمين إلى مدينة دنقلا فدخلها سنة إثنتين وخمسين وستمئة من الميلاد، وبنى المسلمون في فنائها أول مسجد بالسودان”.
تحليل النص:
الكتاب هو في اللغة العربية، ومع ذلك؛ فإن مايود أن يشير إليه الدرس ويريد ترسيخه في عقلية التلميذ، هو أن المسجد هو أول مدرسة كما يقول عنوان الدرس نفسه والإشارات الواردة في متن الدرس.ويبدو ذلك عادياً للغاية عن النظر إليه كموضوع يخص تجويد اللغة. وبصرف النظر عن المغالطة (المعلوماتية) في هذا الجانب، حيث أن عملية التعليم والتعلم لم ترتبط بالمؤسسات ذات الطابع الديني لا في الإسلام ولا غيره إلا في مراحل متأخرة من تاريخ البشرية بشكل عام. وهذا ليس موضوعنا، لكن وبرغم هذه المغالطة يبدو واضحاً أن المراد تكريسه هنا فكرتين أساسيتين هما: (1) ربط التعليم بالأديان وهذا يخدم الجانب الأيديولوجي لواضعي المنهج (2) ربطه بالعروبة أو العرب من خلال الإشارة لدخول العرب السودان وجلبهم للدين والمسجد المشار إليه كأول مدرسة. والمناقشة هي: ألم يكن هناك تعليم أو مدارس أو معارف في السودان قبل هذا التاريخ(؟؟). أوليست هنالك مجموعات أخري غير العرب كانت لديها نظم دراسية ومعرفية(؟؟) وإن كان هنالك هذا النوع من التعليم المدرسي، فلماذا يتم تعمد عدم ذكره(؟).
نموذج (2): كتاب: محور الإنسان والكون، الإنسان يعمر الأرض للصف الرابع أساس طبعة 2004
الدرس (4) الإنسان يبني مجتمعه (صص 117، 118) :
يلخص الدرس موضوع ومفهوم البناء الأسري في المجتمع الإنساني وكيفية تكوُّن الأسرة عن طريق التزواج، ويعطي أمثلة لذلك في الإسلام والمسيحية. حيثأشار :
“يتم الزواج عند النصاري، بواسطة القس وبحضور عدد من الناس”.
تحليل النص:
أولاً الكتاب هو (الإنسان والكون) وحسب مادته، والتي أغلبهاهي مادة العلوم (الأحياء على وجه التحديد) خاصة في الأجزاء الأولى منه. يأتي الجزء الرابع منه مشتملاً على موضوع (الإنسان يبني مجتمعه)، وهو أقرب لعلم الإجتماع منه إلى علم الأحياء (سنأتي على نماذج أخرى فيه). بالرغم من التداخل والخلط ما بين علم طبيعي وعلم إجتماعي في المنهج وهونقاش ليس هذا مجاله، غير أن الملاحظة التي إجتذبت الإنتباه هى الإشارة للمسيحين فيه بــ”النصاري” كما أوردناها في النموذج، وهي إشارة سالبة خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعليم في بيئة إجتماعية متنوعة تضم تلاميذ من أديان مختلفة مسلمين ومسيحين وذوي أديان أخرى. فإصطلاح “نصاري” له إرتباطات وصفية غير متسامحة تضح المسيحين في موقع الأعداء للإسلام إذا إحتكمنا للنصوص الدينية والتاريخية الإسلامية.
(4-5) درس الدولة (صص 129، 130):
يشير هذا الدرس إلى أركان الدولة وهي الأرض، الشعب والسلطة ويذكر في مسألة الشعب:
“.. أنا وأنت وغيرنا، وكل السكان الذين يعيشون في السودان يكونون شعب السودان، وقد إستوطن أجدادنا هذه الأرض، منذ الاف السنين، لذا يطلق عليهم السودانيين، وهذا يعني أن هنالك من يسكنون معنا لا يطلق عليهم إسم السودانيين، إما لأنهم دخلوا السودان حديثاً أو دخل أباؤهم السودان حديثاً ونقول في هذه الحالة الأولى أن جنسيتنا سودانية، وأننا مواطنون سودانيون، ولا يمكن أن نقول نفس الكلام في الحالة الثانية فهؤلاء نقول عنهم أنهم مهاجرون أو وافدون (…) وقد يتحدث سكان أي دولة عدداً من اللغات قد يزيد أو يقل، ولكننا نجد أن لكل دولة لغة واحدة رسمية فنحن في السودان لغتنا الرسمية هي اللغة العربية وهي لغة يتحدث بها عدد كبير من السودانيين وهي وسيلة التخاطب بين السودانيين، وهناك بعض الدول التي تستخدم لغات الدول الغربية التي كانت تستعمر أرضها”
تحليل النص:
هذا النص من النماذج التي يصح فيها القول بأن العنصرية مستضمرة داخله وليست صريحة. ويستشف ذلك كما يقال عادة إلى ماهو (خلف السطور)، أو (مالم يقله النص)، أو (مسكوت النص). فعلي الرغم من أن الحديث يناقش صراحة قضية السكان الأصليين الذين قطنوا السودان، والتي تبدو طبيعية وواقعية في العملية التعليمية، غير أن المعروف أن هذا ملف بالغ الحساسية في السودان ولا يمكن تناوله من دون تدقيق. والإشارة إلى أن هنالك من يطلق عليهم سودانيين وآخرين وافدين لا يمكن أن يطلق عليهم سودانيين يُفهم منه قصد الإشارة إلى قوميات بعينها دخلت السودان خلال حقب تاريخية محددة أو مختارة بإنتقائية، وأغلب الظن أن المشار إليهم هم تلك القوميات التي وفدت من غرب أفريقيا مثال الهوسا أو الفلاتة وغيرهم (أو المجموعات ذات الأصول الإفريقية بشكل عام) والذين أصبحوا سودانيين بحكم الإقامة الطويلة والممتدة في التاريخ.. وعموماً حتى تسمية السودان معروف أنها لم تكن تقتصر على السودان بحدود التاريخية المشار إليها حالياً إلا فيما بعد 18821، بعد الإستعمار التركي. هذا النوع من المناقشات أو النصوص عند إيرادها، وفي ذهنية تلاميذ مدارس الأساس، فإنها تجعلهم يديرون رؤسهم في مجتمعهم بحثاً عن هؤلاء الوافدين، ومن ثم تبدأ أولى خطوات رحلة البحث عن التمييز القائم على أساس العنصر. وطالما أن ما هو مُترسخ في ذهنية هؤلاء التلاميذ من دروس الدين ووالمادة الإعلامية والتاريخ الشفاهي المنقول الذي ما إنفك يكرس لعروبة الدولة وينفي التنوع، إذن فإن كل الذين لا تنطبق عليهم شروط العروبة هم في حكم الوافدين وغير السودانيين. ومع أن ليس هنالك أي إشارة صريحة للجذر العرقي لهؤلاء الوافدين في النص الدراسي، إلا أن ذلك يُفهم من السياق العام والبيئة الإجتماعية. أيضاً الإشارة إلى اللغة ينطبق عليها نفس التحليل، فصحيح أن اللغة العربية هي السائدة وهي لغة التواصل، لكن الإصرار على تسميتها باللغة الرسمية له مدلولاته العنصرية الطابع، في مقابل عدم ذكر اللغات الأخرى، مع العلم أنها كثيرة ومنها ماهو مكتوب. عموماً مسألة إشكاليات اللغات هذه كثير من الدول تجاوزتها في مناهجها وتعاملاتها، وبدأت في إحياء اللغات الأخرى الموجودة في مجتمعاتها ذلك من أجل تطوير مسألة البناء القومي في دولها من خلال عملية الإعتراف بالآخر ومكوناته الثقافية واللغوية وغيرها.
(5 _ 4) درس الهجرة إلى السودان (صص ، 158،159، 156):
يتكلم هذا الدرس عن الهجرات التي جاءت إلى بلاد السودان من مناطق مختلفة وهي حسب الخريطة المرفقة مع الدرس [شكل رقم (5 – 2) “أحد أهم الهجرات إلى السودان منذ أقدم العصور”]. وتشير الخريطة إلى هجرات من مناطق مختلفة الجنوب والغرب والشمال وعبر البحر الأحمر والهجرات الداخلية. و قد لُونت أسهم الهجرات الزنجية بأسهم سوداء اللون والهجرات العربية بأسهم بيضاء اللون. ومن كل هذه الهجرات لم يذكر الدرس في متنه إلا الهجرات العربية حيث يقول:
“.. بدأت هجرات العرب إلى السودان منذ زمن بعيد، عبر البحر الأحمر، من الجانب الشرقي للسودان، وهجرات أخرى جاءت عن طريق مصر من الشمال، وعبر شمال أفريقيا وغربها وترجع أسباب هذه الهجرات إلى التجارة أو طلب المرعي أو طلب الأمن ونجد أن هذه الهجرات لم تؤثر على الأجناس التي كانت تقيم في السودان لقلة عدد المهاجرين وتفرقهم”.
تحليل النص:
يمكن إستقصاء العنصرية هنا بوضوح أكثر من من خلال مدخل الإصرار على ترسيخ فكرة الهجرات العربية وتجاهل الهجرات الأخرى، وأيضاً الإشارة اللونية (الأسود والأبيض) للتفريق بين هجرات الزنج والعرب. والطريف في الأمر حتى أن السؤال الوارد في الدرس للتلميذ يقول : “مالذي يفصل الجزيرة العربية عن السودان؟” وهو سؤال خارج الموضوع بحكم الحدود الجغرافية، فالجزيرة العربية ليست جار للسودان وليست في القارة الإفريقية حتى تتم مطالبة التلميذ بالإجابة عما يفصلنا عنها، ولكن إنما هو جزء من العملية التربوية/التعليمة التي تستخدم التكرار لترسيخ المعلومات، والمراد ترسيخها هنا أن علاقتنا الأقرب والمفترض أن تكون حاضرة في الذهن هي يجب أن تكون مع الجزيرة العربية وليست يوغندا أو الحبشة أو تشاد أو أفريقيا الوسطى، مع أنها كلها دول تربطنا معها قواسم مشتركة كثيرة لا حصر لها بالإضافة لعوامل القرب الجغرافي والتداخل الإجتماعي والإقتصادي.
الملاحظة الأخيرة في هذا النموذج هي أننا مازلنا نتحرك في كتاب هو وبالتصميم كتاب علوم طبيعية (بيولوجيا) أو علم أحياء يتحدث عن التكوين البيولوجي لجسم الإنسانويتداخل في مرحلة من مراحله مع موضوع آخر ليصبح معلومات عن الأسرة والأجناس والهجرات العربية، وهي من الناحية المنهيجة عملية إنتقال بين علوم مختلفة بطبيعة موضوعاتها والمركد أنها قد تثير الكثير من الإشكاليات المعرفية في ذهنية التلميذ.
نموذج (3): كتاب الحديقة: في القراءة والأناشيد للصف الثاني أساس
الدرس الرابع عشر: النخلة (ص 45)
يصف هذا الدرس شجرة النخيل وبيئتها الجغرافية التي تنشأ فيها (الشمال) ونوع الثمر الذي تنتجه وأهميته.
الدرس الخامس عشر: قصيدة شجرة النخيل(ص 59)
قد طاب لي مقيلي *** في ظلك الظليل
بشكلك الجميل **** يا شجرة النخيل
يا جنة الظلال **** يا مسبح الخيال
يا زينة الشمال **** يا شجرة النخيل
…. إلخ أخر القصيدة…
تحليل النص:
الملاحظة في أن هذين الدرسين في موضوع واحد تم إستعراضهما بطريقيتن مختلفتين(نثر وشعر)، والموضوع هو شجرة النخيل والمشار إليه في درس النثر ب(النخلة)، وفي القصيد بـ(شجرة النخيل). وأيضاً يطرح السؤال نفسه لماذا التكرار لنفس الموضوع بطرق مختلفة. كان بالإمكان إعتبار الموضوع عادياً إن تم إستعراضه مرة واحدة تلته تناول شجرة أخرى بمواصفات مختلفة تعكس تنوع السودان مثال شجرة التبلدي الشهيرة في كردفان، أو تم تناوله في سياق مختلف آخر. لكن الإصرار على ذكر شجرة النخيل بهذا التكرار والتتابع (الدرس الرابع عشر والخامس عشر بالتتابع) يفهم منه تكريس مفهوم العروبية من خلال إستعراض البيئة العربية التي تمثل النخلة أحدأبرز رموزها البيئية/الثقافية.
هناك نماذج أخرى أكثر إخفاءاً في الأثر في مواد أخري وهي تلك المواد التي يصعب فيها التلاعب بنصوص الدرس لتكريس الروح العنصرية كالتي أوردناها في النماذج السابقة كمثال مادة الرياضيات أو الحساب. وغالباً مايأتي إدخال هذه الروح من خلال أمثلة أو أسئلة العمليات الحسابية أو الرياضية مثال النموذج أدناه والذي ورد في صفحة 90 تمرين (3 – 3) كمسألة حسابية:
” سجادة صلاة طولها متر ونصف، فكم طول هذه السجادة بالسنتمتر”؟
فعلي صعيد التفكير الرياضي ليس هناك كبير فرق إن كان العنصر المراد قياسه في المسألة المشار إليها سجادة أم قضيب خشبي أو حديدي أو أي شئ آخر، لكن عندما ينظر الباحث للسياق الكلي للعملية التربوية والتعليمة سيفهم إن إيراد سجادة بدلاً من أي شئ آخر ليس مصادفة، خاصة في مادة أساسها يقوم على تطوير قدرات التجريد لدي التلميذ أو الطالب.
خاتمة:
هنالك الكثير من النماذج التي يمكن إيرادها في هذا الصدد ومن مستويات تعليمية مختلفة، والتي يمكنها أن تشهد وتثبت بهذه الدرجة أو تلك الموضوع الذي نتحدث عنه، وهو البحث عن مداخل العنصرية في المناهج التعليمية. وعموماًسيظل هذا موضوع متسع ومتشابك لا يمكن لكاتب واحد خلال محاضرة واحدة أن يلم بأطرافه، لذلك أسمنا الورقة “مدخل لفهم العنصرية في مناهج التعليم السودانية”، وحصرنا النماذج التي أوردناه في بضع كتب من مرحلة الأساس لعلها تلقي بصيص من الضوء على الموضوع وتصبح مدخلاً حافزاً لبحوث أكثر عمقاً تحليلاً للموضوع.
ثلاثة عناصر مثلت مدخل لبحث مسألة العنصرية في المناهج التعليمية وهي:
(1) قضية الإصرار على إقحام النصوص الدينية في مقدمات ومتون كافة الكتب سواء إن كان ذلك بغض التأطير للمواد الدراسية المعنية أو إستشهاداً يحل مكان الإستدلال العلمي. فهو بكل ذلك يتخطي الأسس التي قامت عليها المعرفة العلمية طوال تاريخها عن طريق الإصرار على الربط التعسفي للمعرفة الإنسانية بالماورائيات أو اللاهوت وهي بذلك أيضاً تنسف الأساس العلمي لموضوعات الكتب من أساسه، والقائم على عقلية النقد وروح البحث ونسبية الحقيقة العلمية. هذا في الجوانب الإبستمولوجية والمنهجية المتعلقة بهذا المنهج، ويتمثل الجانب العنصري في التحييز لدين بعينه دون الأديان الأخرى، وهو شكل من أشكال الإستبعاد Exclusion الديني، والذي هو وبالضرورة يفضي إلى كافة أشكال الإستبعادات الأخرى إجتماعية كانت أو إقتصادية أو إجتماعية.
(2) قضية الإصرار على تضخيم الذات العربية في هذه المناهج والتي ترد في أكثر من مثال وبطرق مختلف بغرض التكرار لترسيخ الفكرة الرئيسية ألا وهي (مركزة الذات العربية)في أذهان التلاميذ حتى وإن كان ذلك على حساب صحة الوقائع التاريخية إما بإنكارها تارة أو بالسكوت عنها تارة أخرى. وقد رأينا ذلك من خلال نماذج دراسة الهجرات والنماذج الأدبية التي ترسخ للنخيل أو النخلة أو مناقشة مسألة الذين قطنوا السودان من أقوام ومن هم السودانين ومن هو الوافدين والإشارات الضمنية السالبة في هذا الموضوع.
(3) تداخل مسألة التناول العنصري في مستويات مختلفة Overlapping: فقد قام إعداد المناهج في السودان على نظرية المحاور، بمعني؛ إختيار موضوع ما كمحور وبالتالي ينتشرهذا الموضيع في أكصر من كتاب أو مادة دراسية حتى وإن أدي ذلك إلى التضحية بالإنسجام ووحدة الموضوع. ومثال لذلك النموذج الذي أوردناه من كتاب “الإنسان يعمر الأرض” الطبعة الثانية للصف الرابع أساس. والذي هو بالأساس كتاب يصنف ضمن العلوم الطبيعية، الأحياء على وجه التحديد، فقد تداخل معه علم الإجتماع والذي يعتبر في التصنيفات العلمية ضمن العلوم الإجتماعية أو الإنسانية. وعلى الرغم أن هنالك من يقول أن هذا الأسلوب جيد من حيث أنه يربط كافة القضايا المتشابهة مع بعضها البعض في ذهن التلميذ سواء إن كانت تقع في نطاق العلوم الطبيعية أو الإنسانية، غير أن هذا جدل يخص علماء التربية وواضعي المناهج. فقط ماوددت الإشارة إليه هنا، هو أنه تم إستغلال هذا التداخل بواسطة واضعي المناهج في السودان لتكريس أبعاد أيديولوجية بعينها كما رأينا في النماذج التي أوردناها من داخل النصوص أنها ذات طابع إستبعادي وعنصري صريح في بعض الحالات.
أخيراً وليس آخراً، مازلت أكرر أن هذه الورقة لم تُحط بالموضوع، وماكان لها أن تفعل، ومازال هنالك الكثير في هذه المجال للبحث والتقصي.
التجاني الحاج عبدالرحمن
الخرطوم، في 1 مايو 2015
المراجع:
1. كتاب الحديقة في القراءة والأناشيد، الصف الثاني أساس.
2. كتاب المنهل في اللغة العربية، مرحلة الأساس.
3. كتاب الرياضيات للصف الرابع مرحلة الأساس.
4. كتاب: الإنسان يعمر الأرض للصف الرابع أساس
2015-05-07


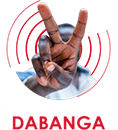

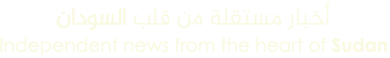
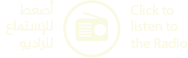
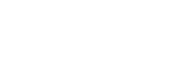
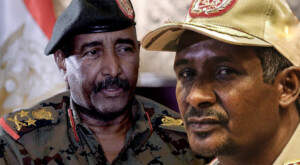



 and then
and then