لا يمكن لأحزاب غير ديمقراطية أن تنتج ديمقراطية
أبهرت ثورة ديسمبر 2018 العالم وشكلت مصدر إلهام للكثيرين على امتداد الكرة الأرضية. وتسآءل الكثيرون خاصة في الغرب: من أين لهولاء الأفارقة الفقراء كل هذه السلمية والتنظيم الدقيق والسلوك المتحضر، في ذات الوقت الذي كان فيه المتظاهرون ينهبون المحلات التجارية ويحطمونها في أرقى عواصم العالم. مع ذلك يرى الكثيرون أن االفئة الوحيدة التي لم تهزها أو تلهمها الثورة السودانية هي النخبة السياسية السودانية

بقلم: ناصف بشير الأمين
أبهرت ثورة ديسمبر 2018 العالم وشكلت مصدر إلهام للكثيرين على امتداد الكرة الأرضية. وتسآءل الكثيرون خاصة في الغرب: من أين لهولاء الأفارقة الفقراء كل هذه السلمية والتنظيم الدقيق والسلوك المتحضر، في ذات الوقت الذي كان فيه المتظاهرون ينهبون المحلات التجارية ويحطمونها في أرقى عواصم العالم. مع ذلك يرى الكثيرون أن االفئة الوحيدة التي لم تهزها أو تلهمها الثورة السودانية هي النخبة السياسية السودانية والتي ظلت كآل البوربون على حالها القديم؛ "لم تنس شيئا ولم تتعلم شيئا!"، واستمرت في صراعاتها الحزبية "القبائلية" المعهودة التي اقعدت البلاد عقودا وكانت السبب الرئيسي وراء سقوط كل تجارب الحكم الديمقراطي في السودان، ولم ترتفع بسلوكها السياسي "القبائلي" إلى مستوى عظمة هذه الثورة والمهام الجليلة والمسؤوليات الجسيمة التي طرحتها أمام الحركة السياسية. والمتأمل للخطاب السياسي لمعظم الأحزاب خاصة في "مركز السلطة" لا يجد طرحا استراتيجيا ناضجا يخاطب جذور الأزمات وقضايا السلام ورتق النسيج الوطني والأمن والطعام وتوفير الخدمات وإعادة بناء الاقتصاد المنهار وتفكيك تركة التمكين والمهام العديدة والمعقدة للانتقال والتحول الديمقراطي والبناء الوطني، وإنما المطروح هو ذات البضاعة القديمة التي لا تتجاوز تعظيم المكاسب الحزبية الذاتية والغرق في الصراعات الحزبية. ويتصرف قسم من هذه الطبقة السياسية وكأن الشعب السوداني لم يسقط دكتاتورية الإسلامويين الفاشية إلا لكي ينصب مكانها دكتاتورية جديدة، سواء تحت اسم الطبقة أو الإثنية أو الطائفة!
يحتاج نجاح التحول الديمقراطي إلى وجود أحزاب ديمقراطية حديثة ورشيدة، هذه قضية مسلم بها، ولا يمكن لأحزاب ذات بنية فكرية لا ديمقراطية أو شمولية أن تنتج ديمقراطية وذلك، ببساطة شديدة، لأن فاقد الشئ لا يعطيه. ينطلق هذا المقال القصير من فرضية أن ضعف التكوين الديمقراطي والمؤسسي هو القاسم المشترك بين جميع الأحزاب السودانية الرئيسية، بسبب طبيعتها وتكوينها الذي يتوزع بين العقائدية الدوغمائية والطائفية الدينية والبنية العسكرية لتنظيمات الكفاح المسلح. ولأن دمقرطة وتحديث الأحزاب يمثلان عملية طويلة ومعقدة وليس حدثا يتم بضربة واحدة، تحتاج الأحزاب للبدء دون تأخير في عملية الإصلاح الحزبي التحديثي والديمقراطي، بما يؤهلها لتحمل مسؤوليتها والاستجابة لتطلعات هذه الثورة العظيمة وانجاز مهامها العديدة والصعبة، وحمايتها من خطر الثورة المضادة.
تمثل أزمة غياب مشروع للبناء الوطني وبناء الدولة، منذ الاستقلال، أبرز تجليات أزمة الحزبية السودانية. بلغت هذه الأزمة أقصى تجلياتها خلال سنوات حكم الإسلامويين، بسبب فاشيتهم الدينية، وعدائهم للديمقراطية، والتي تجلت في حروبهم الجهادية ضد مواطني الهامش، وسياسات التمكين السياسي والاقتصادي التي تبنوها. وكانت الحصيلة، من بين كوارث كثيرة، فصل جنوب البلاد وتمزيق النسيج الوطني، على ضعفه، وارتكاب الإبادة الجماعية وتدمير الاقتصاد الوطني والافقار المنظم للمواطنيين وحزبنة وتدمير مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية..إلخ. ويمثل فصل الجنوب وجريمة الإبادة الجماعية أكبر حدثين في مرحلة ما بعد الاستقلال، ويشكلان لوحدهما سببا كافيا لأن تجري جميع الأحزاب السياسية السودانية، دون تأخير، مراجعات شاملة وجذرية لبرامجها وأطرها الفكرية، بما يؤهلها لتحمل مسؤولياتها الوطنية والقيام بأدورارها بفاعلية ويضمن وحدة ما تبقى من البلاد على أسس جديدة، وعدم تكرار وقوع كارثة وطنية كبرى بحجم الإبادة الجماعية في المستقبل. ومشروع البناء الوطني الذي تحتاج الأحزاب السياسية لامتلاكه هو مشروع متكامل بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولكن سيتم التركيز في هذا المقال القصير على قضية الإصلاح الديمقراطي والمؤسسي للأحزاب، لمركزية قضية الديمقراطية معا في مشروع البناء الوطني وفي عملية إعادة بناء وتحديث الأحزاب.
إذا نظرنا نظرة متفحصة إلى الانقسامات والخلافات التي ظلت مستمرة بين مكونات قوى الحرية والتغيير منذ لحظة ميلادها والصراعات الدائرة حول المحاصصات في أجهزة الحكم الانتقالي ومحاولات إقصاء مكونات بعينها، نجد أنها تمثل أعراضا وتجليات لأزمة أعمق تشترك فيها كل أو معظم هذه الأحزاب وهي أزمة غياب الديمقراطية وقبول الآخر المختلف في أيديولوجيات وبرامج معظم هذه الأحزاب، وفي تقاليد عملها وأنشطتها السياسية والتنظيمية. فالديكتاتورية ليست ماركة مسجلة باسم الإسلامويين وحدهم، وإنما تشترك معهم فيها معظم الأحزاب السودانية، وما يميز الإسلامويين ليس هو شموليتهم وعدائهم للديمقراطية فحسب وإنما فاشيتهم الدينية. فالبرغم من كثرة الحديث عن الديمقراطية في خطابات كل القوى السياسية، نجد أن الالتزام العملي والجدي بمعايير الديمقراطية وقبول الآخر غائب كليا أو جزئيا في الممارسة السياسية اليومية، وتسود بدلا عنه ثقافة اقصاء ونفي الآخر. فالآخر في خطاب كثير من الأحزاب التي تدعي العمل من أجل التغيير هو إما عميل خائن أو ناقص الوطنية، مثلما هو "كافر" أو "زنديق" في خطاب جماعات الإسلام السياسي. وفي حين يقتضي الالتزام الجدي بالديمقراطية وجود القناعة الراسخة بالتعددية واحترام التنوع والتعدد واعتبارهما الأصل في الأشياء، وأن التعدد الاجتماعي-الاقتصادي (الطبقي) والثقافي يستلزم بالضرورة إقرار واحترام التعددية السياسية، وأن الحزب أي حزب هو منظمة تعبر عن مصالح قسم أو شريحة اجتماعية معينة من المجتمع، وأنه لا يوجد حزب يعبر عن مصالح وتوجهات كل المجتمع، وبالتالي فإن الحزب هو بطبيعة الأشياء جزء من كل. وانطلاقا من هذا الفهم، النظر للآخر المختلف كشريك يملك أسهما متساوية في المجتمع، والاستعداد للتنافس الديمقراطي النزيه مع الآخرين لنيل التفويض الشعبي وقبول نتائجه. ونتيجة لغياب هذا الوعي الديمقراطي كليا أو جزئيا، فإن الخطر على مسيرة التحول الديمقراطي لا ينحصر فقط في دولة الإسلامويين العميقة وبقايا الثورة المضادة، وإنما يشمل أيضا التكوين غير الديمقراطي للأحزاب والذي يتجلي في التناحر والمعارك الجانبية بين قوى التغيير الناتج عن الفشل في قبول الآخر وإدارة الاختلافات بطريقة ديمقراطية. وبالتالي فإن الفشل في مهام الإصلاح الحزبي يمثل أحد أكبر مهددات التحول الديمقراطي. هذا نقد على صرامته هدفه إصلاح الأحزاب وليس ذمها أو التقليل من شأنها كما سيبين، وذلك لأن وجود الأحزاب، مهما عظمت اشكالاتها وعللها، ضروري لعمل النظام الديمقراطي؛ فلا ديمقراطية بدون أحزاب.
تحتاج الأحزاب الطائفية التقليدية للبدء في عملية تحديث شاملة تنتقل بموجبها من وضعيتها الحالية الشبيهة بالمؤسسات الخاصة المملوكة لأسر بعينها إلى أحزاب حديثة وديمقراطية ومفتوحة للعامة، بحيث يستطيع أي مواطن عادي (عمليا وليس نظريا) أن يتدرج في سلم هرمها التنظيمي حتى رئاسة الحزب. ويتطلب ذلك، من بين أشياء أخرى، الفصل ما بين الطائفة والحزب، كما فعل رئيس حزب الأمة السيد الصادق المهدي في زمان سابق، قبل أن يتراجع ويعود ثانية ليجمع بين "الاُختين": رئاسة الحزب وإمامة الأنصار. هذا الفصل ضروري لتمييز ما هو سياسي ومدني عما هو طائفي وديني (مقدس). وتحتاج ثانيا لتحديث نفسها من خلال بناء مؤسسات وهياكل حزبية ديمقراطية ذات فعالية ومصداقية، وأن يتم احترام شرعية تلك المؤسسات وقراراتها والالتزام بالعمل داخلها باعتبارها القنوات الشرعية التي يجب ألا تتم عملية اتخاذ القرارات الحزبية إلا داخلها. وأن تضمن وقف وحظر قيام القيادات العليا بالانفراد بعملية اتخاذ القرارات السياسية خارج المؤسسات وبمعزل عنها. وهذا المتطلب الأخير تشترك فيه الأحزاب الطائفية التقليدية مع سائر الأحزاب والحركات السياسية الأخرى. والإصلاح البرامجي مقدم على الإصلاح التنظيمي والمؤسسي وهو يقوده ويشكل إطاره الفكري. وفي ذلك ينتظر من الأحزاب التقليدية أن تعبر عن التزامها الكامل، من بين أشياء أخرى كثيرة، بالدولة المدنية الديمقراطية التي تحترم التنوع الديني والثقافي والإثني في السودان وبحقوق المواطنة المتساوية، وأن تطرح برنامجا تنمويا يعطي مضمونا اجتماعيا للديمقراطية اللبرالية، وأن تلتزم بالفصل بين ما هو سياسي وديني.
في مقررات مؤتمريه الأخيرين، أكد الحزب الشيوعي السوداني على تمسكه بالماركسية كإطار مرجعي للحزب، وينتظر لذلك من الحزب الشيوعي إجراء إصلاحات وتقديم إجابات للأسئلة الملحة حول الكيفية التي سيوفق بها بين تمسكه المعلن بالماركسية اللينينية من جهة وبين الالتزام "الجدي" بأسس النظام الديمقراطي التعددي على المدى الاستراتيجي، وذلك بدل الاكتفاء بترديد شعارات الديمقراطية. فكيف يمكن لأي كيان أن يكون ديمقراطيا دون أن تتوفر لدية قناعة حقيقية وصلبة بالتعددية السياسية!؟ من منظور ماركسي صرف، فإن التحول الديمقراطي المنشود بعد انتصار ثورة ديسمبر 2018 المجيدة ليس هدفا لذاته، وأنما هو خطوة باتجاه مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية التي تمهد بدورها لمرحلة الاشتراكية، وهي المرحلة التي يتم فيها القضاء على الملكية الخاصة، ثم تأتي الأممية كمرحلة حتمية ونهائية في تاريخ البشرية وكتطور تاريخي للاشتراكية، وهي المرحلة التي يتم فيها القضاء على الدولة. ولا يوجد في المرحلتين شيء اسمه تعددية حزبية أو سياسية وإنما حكم الحزب الواحد الذي يحكم باسم ونيابة عن الطبقة العاملة ويفرض دكتاوريتها. فدكتاتورية البروليتاريا هي النظام السياسي الذي يسود في مرحلة الانتقال من الرأسمالية إلى الشيوعية، وفق مبادئ الماركسية اللينينية (لينين، الدولة والثورة). هذا من ناحية مكانة الديمقراطية في برنامج الحزب، أما فيما يخص التنظيم الحزبي، فنجد أن نظرية "الديمقراطية المركزية" المعروفة بمركزيتها ولا ديمقراطيتها هي التي تحكم العلاقات الداخلية في تنظيم الحزب. ويحتاج الاثنان لمراجعات نقدية جذرية وجدية، كما فعلت بنجاح أحزاب ماركسية ويسارية في دول عديدة، قبل وبعد انهيار المعسكر الشرقي.
وينطبق ذات الشئ على أحزاب القومية العربية التي تتبنى نظام الحزب الواحد والديمقراطية المركزية، وتعمل من أجل تحقيق هدف مركزي هو الوحدة العربية، وليس البناء الوطني والتحول الديمقراطي في الدولة الوطنية – التي لا تعترف أصلا بشرعيتها وتعتبرها كيانا صنعه الاستعمار.
تشترك حركات الكفاح المسلح أيضا في أزمة غياب الديمقراطية بسبب سيادة التراتبية العسكرية القائمة على طاعة الأوامر الصادرة من القيادات العليا التي تحكم تنظيماتها وعلاقاتها الداخلية، وذلك بالرغم تميزها بايجابية التزامها نظريا بمبادئ الحكم الديمقراطي وعدم تبنيها لفكر عقائدي مغلق. وفي ظل ظروف التحول والانتقال نحو الديمقراطية والحوار الجاد الذي يجري الآن بهدف تحقيق السلام ووقف الحرب، لا سبيل أمام هذه الحركات سوى البدء دون تأخير في إجراء إصلاحات جذرية تتحول بموجبها من العمل المسلح إلى العمل السياسي السلمي وسط الجماهير، عبر بناء تنظيمات ديمقراطية ومنفتحة.
إن نجاح الأحزاب السودانية في القيام بمهام الإصلاح السياسي والتنظيمي المشار إليها يتوقف على إدراك عضويتها وقياداتها واقرارها بالحاجة للإصلاح البرامجي والمؤسسي الشامل ورغبتها في ذلك. ويمكن للحكومة الانتقالية ومنظمات المجتمع المدني وأصدقاء السودان أن يساهموا جميعا في عملية الإصلاح الديمقراطي للأحزاب وتأهيلها. ستسمح عملية الإصلاح الحزبي بوصول جيل جديد لقيادة الأحزاب يمثل الشباب الذي صنع هذه الثورة والذي يمثل حوالي ثلثي الشعب السوداني. وسينعكس ذلك ولو بصورة تدريجية وبطيئة على أداء الأحزاب وعلاقاتها البينية، وسيحل التعاون والتنسيق والتفاهمات المشتركة مكان التناحر القبائلي والمعارك اليومية التي تستهلك وتبدد طاقة وزمن الأحزاب وتسمم المناخ السياسي وتشكل خطرا على الثورة. سوف يتوقف نجاح عملية التحول الديمقراطي، على المديين القصير والطويل، على نجاح الأحزاب في هذه المهمة، مهما استغرقت من وقت؛ فلا يمكن لأحزاب غير ديمقراطية أن تنتج ديمقراطية.





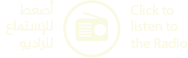
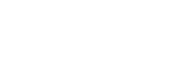




 and then
and then