في ذكرى بداية الاعتصام في 6 أبريل 2019 .. ثورة ديسمبر إلى أين؟
تمر علينا هذه الأيام الذكرى الأولى لبداية اعتصام الثوار، أمام مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة. ولابد من اتخاذ هذه المناسبة فرصةً لكي نتساءل عما أنجزته الثورة، في عامها الأول، وعما يشي به مسارها، في مقبل الأيام. وأول ما يلفت النظر في هذا التفحص، ربما كان التباين الحاد بين دفق الثورة، وروحها المتوثب، اللذان وسما مسيرتها، حتى انتصرت، وبين ما يشبه العمل الروتيني، الذي وسم أداء الفترة الانتقالية.

بقلم: د. النور حمد
تمر علينا هذه الأيام الذكرى الأولى لبداية اعتصام الثوار، أمام مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة. ولابد من اتخاذ هذه المناسبة فرصةً لكي نتساءل عما أنجزته الثورة، في عامها الأول، وعما يشي به مسارها، في مقبل الأيام. وأول ما يلفت النظر في هذا التفحص، ربما كان التباين الحاد بين دفق الثورة، وروحها المتوثب، اللذان وسما مسيرتها، حتى انتصرت، وبين ما يشبه العمل الروتيني، الذي وسم أداء الفترة الانتقالية.
هناك ملمحان رئيسان ميزا هذه الثورة، هما: سلميتها الصارمة التي لازمت مواكب المتتالية، منذ بدايتها، في ديسمبر 2018. ومحافظتها عليها، على الرغم من القتل الممنهج للثوار، والقمع الفظيع، الذي استمر لأربعة أشهر. صمد الثوار إلى أن اختل ميزان القوى لمصلحتهم، باعتصام القيادة العامة، الذي بدأ في السادس من أبريل، 2019. وقد عكس ذلك الاعتصام المبهر، رمزيةً عبَّرت عن أمل الشعب المسالم، الأعزل، في أن تقف قواته المسلحة، إلى جانبه، في معركته المصيرية، ضد سلطةٍ، فاسدةٍ، باطشة. جذب الاعتصام، وسائط الإعلام الدولية، وشكل ضغطًا رهيبًا، على سلطة الرئيس البشير، وعلى كبار قادة الجيش، ومعهم سائر القوى الحاملة للسلاح. واضطرت قيادة الجيش، تحت الضغط المتنامي، من الداخل، والخارج، أن تطيح بالرئيس، البشير بعد خمسة أيام من بداية الاعتصام.
لم تكن القوى الحاملة للسلاح، التي أزاحت الرئيس، البشير، مؤمنةً، إيمانًا حقيقيًا، بالثورة. بل، كانت تقرأ التحولات الجارية، أمام عينيها، بنفس الذهنية، التي سادت في عهد الرئيس البشير. فاللجنة الأمنية التي كونها الرئيس البشير، في أخريات أيامه، للتعامل مع الأزمة، بقيت تعمل وفق نفس التصور الذي على أساسه أُنشئت. أظهر خطاب تنحية الرئيس البشير، الذي أذاعه الفريق، عوض ابن عوف، أن خطة اللجنة الأمنية، هي إزاحة الرأس، مع الإبقاء على بنية النظام. فسخر الشعب من الخطاب، واضطرت اللجنة الأمنية إلى تنحية الفريق، عوض بن عوف، بعد يومٍ، واحدٍ، من تنصيبه. ولاحقًا، أُزيح، عضوٌ اللجنة الأمنية، الفريق عمر زين العابدين، ولحق به آخرون. لكن، وكما هو متوقع، بقيت العقلية الإنقاذية، هي المسيطرة، محاولةً حبس الأمور في إطار تغييرٍ شكليٍّ، والإبقاء على دولة البشير الموازية، بأيديولوجيتها، وبامتيازات نخبها، وعلى رأسها النخب العسكرية.
رغم التظاهر بقبول الاعتصام، ورغم الوعود المتكررة بعدم وجود نية لفضه، قامت القنوات الفضائية، والصحافة المناوئة للثورة، بحملةٍ شرسةٍ، لشيطنة الاعتصام، بأساليب غايةً في الدناءة. في الثالث من يونيو، أي بعد 53 يومًا من تنحية الرئيس، البشير، هجمت، على منطقة الاعتصام، قواتٌ مختلطةٌ، فقتلت المئات. وصاحبت القتل، اغتصابات للفتيات، كما جرى رميٌ جثث بعض الشباب، في النيل، بعد أن رُبطت أقدامهم على كتلٍ أسمنتية، لكيلا تطفو. ظنت مختلف القوى؛ من العسكريين ومن المدنيين، الذين وافقوا على فض الاعتصام، أن الثورة قد انكسرت شوكتها، وأن في وسعهم رسم صورة المرحلة الجديدة، كما يحبون. لكن موكب 30 يونيو، التاريخي، الذي جرى بعد 27 يومًا، من فض الاعتصام، قلب الموازين الدولية، والإقليمية، والمحلية، وأربك جهود الالتفاف على الثورة. من هنا، بدأت المفاوضات بين الشقين العسكري، والمدني، ودخلت وساطة الاتحاد الإفريقي، والوساطة الإثيوبية، حتى خرج الجميع بالوثيقة الدستورية، التي ستحكم الفترة الانتقالية، التي تمتد لثلاث سنوات. جرى التوقيع على الوثيقة الحاكمة، في 17 أغسطس 2019؛ أي، بعد تسعة أشهرٍ من اندلاع الثورة.
رأت القوى الإقليمية، التي سبق أن جرَّت إلى معسكرها الرئيس البشير، في الثورة، فرصةً مواتيةً، لإقامة نظامٍ تابعٍ لها في السودان، شبيهًا بنظام الفريق، السيسي، في مصر. وقد انخرطت تلك القوى الإقليمية، منذ بداية الثورة، في إغواء بعض القيادات السياسية، والعسكرية، لتقوم لها بدور حصان طروادة الذي يصب حصيلة الثورة السودانية، في حاوية استراتيجيتها الإقليمية. ولعل ملابسات فض الاعتصام، الذي كان نسخةً من تجربة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، في مصر، قد أظهرت هذه اليد الإقليمية، بوضوح كبير.
المشهد الماثل وتحدياته
لن تقف المقاومة للثورة، ولن تقف محاولات الحؤول بينها وبين تحقيق أهدافها. لكن، هناك عددٌ من أوجه القصور في أداء قوى الثورة. منها التعتيم على القضايا الحرجة، العالقة، وتجنب مناقشتها في الهواء الطلق. وتقف وراء هذا التعتيم مخاوف، ودوافع مختلفة. منها، خوف قيادات الحرية والتغيير من غضب الشارع، خاصةً فيما يتعلق بكشف أسماء المسؤولين عن جريمة فض الاعتصام، ومحاسبتهم. ومنها، أيضًا، سيطرة التفكير الأحادي، الثأري، على قسمٍ معتبرٍ من مجاميع الشباب، التي تريد فرض إرادتها، على القيادات، وسائر مكونات المشهد، دون التفاتٍ إلى حقيقة ما يمكن تحقيقه في ظل التعقيدات القائمة. ولا يوجد، حتى هذه اللحظة، عرضٌ، أمينٌ، وشجاعٌ، لتعقيدات المرحلة، التي نمر بها، ولا عملًا واضحًا، في تفكيك قنابلها الموقوتة، المبثوثة، في كل ركن. فالنكوص عن مواجهة هذه التعقيدات، وعرضها بأمانةٍ، وشجاعةٍ، ووضوح، هو السبب وراء هذا الصراع الكتيم، المملوء نفاقًا، وكيدًا، ومراوغة.
القوى المسلحة، من قوات مسلحة، وقوات دعم سريع، ليست جسمًا واحدًا. وتمثل قوات الدعم السريع جسمًا ذا وزنٍ كبيرٍ في المعادلة العسكرية القائمة. كما تمثل أقوى الحلقات في التقاطعات الإقليمية مع الداخل السوداني. يتعامل هذان الجسمان العسكريان الكبيران، مع بعضهما بحذرٍ شديد. وفي الجانب الآخر، من المشهد، هناك الحركات المسلحة. وهناك القوى المدنية التي كانت تدعم حكم الإنقاذ، وأصبحت تميل عقب الثورة إلى القوى العسكرية، وتعمل، على تشجيع العسكر، على إفشال حكومة الفترة الانتقالية، لكي تتحقق رغبتها في إجراء انتخابات مبكرة. باختصار، هناك تشققات وسط الكيانات الموالية للثورة. كما أن هناك خيوطًا، مختلفة السماكة، تربط بين كافة القوى المناوئة للثورة، وسط العسكريين، ووسط المدنيين.
ورطة الاعترافات
تمثل الاعترافات المسجلة، التي أثبتت أن المجلس العسكري، قرر مجتمعًا، بعد أن تشاور مع أطرافٍ مدنية، فض الاعتصام، واحدة من المخانق العويصة. بذلك الاعتراف المسجل، أصبح شبح جريمة فض الاعتصام، هاجسًا حاكمًا لخيارات العسكريين، وتصرفاتهم. فقد جعلهم أمام خيارين، الأول: شراء الوقت، وأصبح هذا متاحًا بحكم بأن الفترة الانتقالية، منحتهم حصانةً من المساءلة القانونية، لثلاث سنوات. أما الخيار الآخر، فهو قلب الطاولة واستلام السلطة؛ إما منفردين، وهذا احتمال ضعيف. وإما بالتحالف مع الحركات المسلحة، وبعض القوى الحزبية، التقليدية، مع دعم من الإقليم.
يتطلب تفكيك هذا الوضع المعقد، شجاعةً استثنائية، وإدراكًا شاملاً وعميقًا، وتقييمًا، دقيقًا، للمخاطر والفرص، وقدرةً على الموازنة بين الخيارات، وعلى نزع فتائل القنابل الموقوتة. فالعسكر لن ينتظروا أن تنتهي الفترة الانتقالية، على النسق الذي رُسم لها، ليفقدوا حصانتهم التي ضمَّنوها في صلب الوثيقة الدستورية، لتصبح رقابهم، متاحةً للمقاصل، أو تصبح امتيازاتهم عرضة للتفكيك. وهم، كما سبق أن ذكرت، ليسوا وحدهم، في الحرص على اجهاض الثورة. فهناك قوى حزبية، ذات وزنٍ معتبر، لها أجندتها الخاصة، تنسق معهم، بقدرٍ من المقادير. المخرج من هذا الوضع الشائك، فيما أرى، هو اتباع الأنموذج الذي جرى في جنوب إفريقيا، وفي المغرب، مع سودنته. أي، المكاشفة، والمصارحة، والمصالحة، وإبراء النفوس، وجبر الأضرار، عبر إجراءات ما يسمى العدالة الانتقالية. فالمسار الذي رسمته الوثيقة الدستورية، ليس كافيًا، ولا ضامنًا، وحده، لعبورٍ آمن. ما أراه بوضوح، أن هناك تجنبًا لمناقشة القضايا الحرجة، بالصراحة الكافية. وهو ما سيذهب بريح الثورة وأهدافها، في نهاية المطاف. فالتاريخ يخبرنا، كيف أجهض الحماس، العديد من الثورات، بسبب قلة النضج السياسي، وتجاهل توازنات الواقع، ومحاولة القفز من فوقها
الثورة عبر صندوق الاقتراع
ما من شك أن الشباب غير المنضوين تحت اللافتات الحزبية، مُضافًا إليهم المنتمون إلى الأحزاب، هم العنصر الرئيس في حماية الديمقراطية المقبلة، وحمايتها. أي، ألا تصبح نسخةً مكررةً من الديمقراطيات الثلاث، اللواتي مضين، وتميزن، جميعهن، بالأعطاب المقعدة. لكن، هناك شروط لابد من استيفائها حتى تصبح طاقة الشباب الضخمة، هذه، كابحًا ضد الانزلاق في الحفر التي ابتلعت، الديمقراطيات الثلاث، من قبل. وفيما أرى، هناك طريقان، الأول: أن تقتحم هذه الكتلة الشبابية الضخمة، بالغة الحيوية والنشاط، أجسام الأحزاب الرئيسة، فتسهم في دمقرطتها، ومأسستها، وإصلاح برامجها، وتجديد خطابها، وتبديل قياداتها. والطريق الثاني: أن تشكل هذه القوى الشبابية، كتلةً حزبيةً، عريضةً، جديدةً، تمامًا. وأن تجر إليها المتململين من الشباب داخل الأجسام الحزبية القائمة، بمختلف توجهاتها، ليصبح للثورة صوتٌ مؤثر في مسار الديمقراطية المقبلة. اختيار واحدٍ من هذين السبيلين هو الذي سوف يجعل من صندوق الاقتراع خادمًا لأهداف الثورة. فصندوق الاقتراع هو الذي سيحدد مصير أهداف الثورة، في نهاية المطاف، وليس المواكب في الشارع. لكن، لن يتيسر أي شيءٍ من هذا، قبل تجاوز العقبات التي سبق أن ذكرت.
تمضي الأيام سراعًا، وسوف تؤول قريبًا رئاسة المجلس السيادي، للشق المدني. وأرجو أن تُمنح رئاسته لشخصٍ من دارفور. فهل ستمنح تلك النقلة المدنيين سلطة القرار، التي بها يفككون فتائل القنابل الموقوتة، ويحققون انسجامًا، مستدامًا، بين المدنيين والعسكريين، وفي نفس الوقت، يزيلون الدولة الموازية، ويعيدون الولاية على المال العام، لوزارة المالية، وبنك السودان؟ لقد انزلقنا، على يدي الانقاذ، في منزلق النموذج المصري، الذي نشأ في حقبة الرئيس مبارك، واستمر بصورة أقوى في عهد الرئيس السيسي. يجعل هذا النموذج، من جنرالات الجيش، أباطرةً في دنيا المال والأعمال، ما يجعل تحقيق حكم مدني ديمقراطي، مستحيلا. خلاصة القول، لن تعبر الثورة، ولن تستعيد الدولة السودانية عافيتها، وقدرتها على تأدية وظائفها الطبيعية، إلا بتفكيك هذا النموذج. وينبغي علينا أن نعي أن تفكيك التمكين، له شقان. فإلى جانب تفكيك التمكين في المؤسسات المدنية، ينبغي أيضًا تفكيك شقه العسكري، المتمثل في الأعمال التجارية المملوكة حصرًا، للقوى العسكرية، والأمنية. هذا الشق هو الأصعب، والأكثر وعورة. فهل سيجتمع العسكريون والمدنيون على صيغةٍ، متوازنةٍ، تسمح للدولة السودانية باستعادة عافيتها، أم سندخل في دوامةٍ جديدةٍ من إضاعة الجهد، والوقت، وفرص الأمن، والاستقرار؟





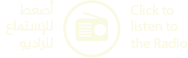
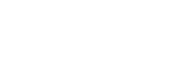




 and then
and then