فتحي الضَّو: لماذا نحب الله والوطن والديمقراطية؟! ..
جاء العيد ومضى مثل سائر الأعياد والأيام، لا فرق. ولكني لم أر في حياتي أناساً حفظوا الود والوفاء لأبي الطيب المتنبي مثلما فعلنا نحن معشر السودانيين …
 فتحي الضو(ارشيف)
فتحي الضو(ارشيف)





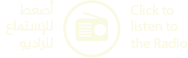
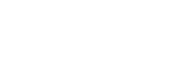




 and then
and then