إنفصال جنوب السودان ….. ورقة إتهام 1/2
الأمم التي تفشل في التعلم من تاريخها محكوم عليها بتكراره” وينستون تشرشيل …
انفصال جنوب السودان ….. ورقة إتهام 1/2
بقلم: نبيل أديب عبدالله المحامي
"الأمم التي تفشل في التعلم من تاريخها محكوم عليها بتكراره" وينستون تشرشيل
في أمسية صيفية من أمسيات الخرطوم بالغة الحرارة إحتمى لفيف من مفكري السودان وسياسيه بقاعة مكيفة في منزل الوجيه صالح عبد الرحمن يعقوب، البالغ الأناقة، تلبية لدعوته لهم للإستماع إلى الدكتور سلمان محمد احمد سلمان، حيث قدم لهم آخر ما قدمه للمكتبة السودانية من مؤلفات وهو كتابه "إنفصال الجنوب ….مسؤولية القوى السياسية الشمالية". الكتاب هو سفر ضخم كادت صفحاته أن تصل الألف صفحة، بما يحمله من وثائق بالغة الأهمية، إحتوت على كل ما يجب أن يطلع عليه من يريد معرفة أسباب إنفصال جنوب السودان .
سيحتاج هذا الكتاب لزمن أطول بكثير من الزمن الذي تيسر لي منذ أن أهداني الصديق العزيز نسخة منه، وحتى كتابه هذا المقال، لهضم كل ما جاء فيه من معلومات وأفكار وأطروحات، وهي أطروحات بالغة العمق كما تعودنا من صديقنا سلمان. على ضوء ذلك فهذا المقال لا يعدو أن يكون إنطباعاً أولياً قصدت أن اشارك القراء فيه بغرض التعريف بهذا المجهود الضخم، ودعوتهم لدراسة متعمقة له، ليس فقط بإعتباره توثيقاً مهماً لتاريخ مازال بعض من الذين حضروه يتشكل أمام أعينهم أحياء يمكن لهم أن يدلوا بدلوهم فيما شمله، أو لم يشمله، هذا السفر من وقائع، ولكن أيضاً لأن إستيعاب ما جاء في الكتاب يساهم في معالجة ما نعايشه الآن من مشكلات بعضها ناجم عما خلفه الإنفصال من مشاكل، ولكن أكثرها تسببت فيه نفس العوامل التي قادت إلى الإنفصال .
ورقة الإتهام
"إن لجنة الدستور قد أولت مطالب الجنوبيين للحكم الفيدرالي إعتبراً جاداً للغاية، وتوصلت إلى أن ذلك لن يكون مجدياً للسودان" قرار لجنة الدستور بخصوص مقترح النظام الفيدرالي لجنوب السودان، يونيو 1958.
"إن شعب جنوب السودان قد أعطى مقترح الوحدة الجاذبة إعتباراً جاداً للغاية، وقرر من خلال الإستفتاء أنه لن يكون مجدياً للجنوب".
قراءة في نتيجة إستفتاء جنوب السودان.
الكتاب هو ورقة إتهام للمكونات السياسية الرئيسية للسودان الشمالي، والتي ساهمت جميعاً في تسبيب إنفصال الجنوب ، حسبما إستخلص المؤلف من دراسته لكافة الظروف والملابسات التي قادت لذلك الإنفصال، والتي تتبعها المؤلف بدءً من مؤتمر جوبا 1947 وحتى التصويت فيما يشبه الإجماع على إنفصال الجنوب في مقتبل العشرية الثانية للألفية الثالثة. النتيجة التي توصل إليها المؤلف هي أن جميع القوى السياسية الفاعلة في شمال السودان، قد ساهمت بشكل او آخر، وبدرجات متفاوتة في المحصلة النهائية التي وصل إليها الأمر، وهي إنفصال الجنوب. بعضها بفشله في التعرف على جذور المشكلة، وبالتالي تقديم المعالجات التي يمكن لها أن تعالجها، وذلك بقصور الرؤيا حين غلّب الإيديولوجيا الضيقة ذات الطبيعة الوحدانية على واقع متعدد، والبعض الآخر بعدم الجرأة على الوقوف في وجه التيار العاطفي وغير العقلاني الذي قاد البلاد إلى تلك النتيجة الكارثية. وهذه النواقص، في رأي المؤلف، لم تقتصر على فصيل دون الفصائل الأخرى، بل شارك فيها الجميع بدرجات متفاوته، من موقع السلطة، إما بالفشل في إتخاذ القرار الصحيح، أو بالجرأة على إتخاذ القرار الخاطئ، حتى لم يعد هنالك مناصاً من الإنفصال.
لعنة الدولة القومية
حصل السودان على إستقلاله في زمن كانت فكرة الدولة القومية والتي تقوم على أن مشروعية الدولة تنبع من تأسيسها على حق الشعب المكون من قومية في تأسيس دولته، هي الفكرة المسيطرة على المناخ السياسي السوداني. لم يكن هنالك أصلاً صراع بين الإنتماء العربي، والإنتماء الأفريقي، على النحو الذي سنشاهده فيما بعد في السيتينات والسبعينات من القرن الماضي، وقد تم إنضمام السودان لجامعة الدول العربية كمسألة طبيعية، وغير مختلف عليها، فهي منظمة إقليمية عريقة سبق تأسيسها تأسيس الأمم المتحدة بعدة شهور، وكانت آنذاك تضم سبع دول فحسب، ولم يكن هنالك خيار أفريقي، لأنه كان علينا أن ننتظر حتى عام 1963 ليتم تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية والتي كان السودان من مؤسسيها.
صادف إستقلال السودان وإنضمامه لجامعة الدول العربية صعود مناخ فكري وسياسي في المنطقة العربية يقوم على إعلاء الشعور القومي، وهو شعور كان يمثل خطراً على واقع الدول العربية بسبب تجاوزه للحدود الدولية لتلك الدول، ومطالبته بإلغاء تلك الحدود لتحقيق الدولة العربية الواحدة، وهي حدود تم رسمها نتيجة لتجزئة الإمبراطورية القديمة إلى وحدات سياسية حددتها ظروف تاريخية سابقة للتكوين القومي. واقع الأمر أن التطور الذي شهدته المنطقة العربية مخالف للتطور الذي شهدته الإمبراطوريات الأخرى. ففي الوقت الذي كانت الإمبراطوريات المعروفة قد تكونت من خضوع عدد من القوميات لحاكم واحد تتمثل فيه سيادة الدولة، فإن فكرة الدولة القومية تقوم على سيادة الأمة المبنية على حق كل قومية في أن تقيم دولتها الخاصة بها، وبالتالي فقد أدت قيام فكرة الدولة القومية إلى تفتيت تلك الإمبراطوريات إلى دول قومية في حين أن تفتيت الإمبراطورية العثمانية نشأ عنه تجزئة القومية العربية إلى عدد من الدول مشكلة من وحدات سياسية لا تقوم على القومية بل على إعتبارات أخرى مختلفة. وقد أدى هذا الوضع لنشوء دعوة قوية لإعادة توحيد القومية العربية تحت لواء دولة واحدة، قادها حزب البعث في العراق وسوريا، وجمال عبد الناصر في مصر وإن كانت لكل منهم أفكار مستقلة وفي بعض الأحيان متعارضة عن الآخر، وهي دعاوي تمت مقاومتها بشدة بواسطة حكام الدول العربية ولكنهم فضلوا مواجهتها بالإشادة اللفظية بالفكرة عوضاً عن التورط في أي مشاريع عملية لخلق دولة واحدة على أساس قومي.
خلافات الرؤى بين النظرية والواقع
رغم أن فكرة القومية العربية لم تستهوي القيادات السياسية السودانية في جانبها العملي، والمتصل بالدخول ضمن وحدة عربية مع الدول العربية الأخرى، خاصة وأن السودان كان حديث عهد برفض الوحدة مع مصر، إلا أن المناخ السياسي السوداني، والذي كان بشكل عام متأثراً بإنتصارات ناصر على النفوذ الإستعماري الأجنبي، جعل نطاق البحث عن مشروعية الدولة الجديدة ينحصر في الفكر القومي دون سواه. وهكذا عمد الساسة الشماليون إلى تأسيس مشروعية الدولة السودانية بشكل أو آخر على أساس قومي، لأن الدولة يجب ترتكز، في نظرهم، على وحدة الدين، واللغة، والتاريخ، فوحدة تلك العناصر وحدها هي التي يمكنها أن تخلق شعوراً وطنياً موحداً، وهو ما تحتاجه دولة حديثة الإستقلال تبحث عن هوية توحدها. لم يرمي الساسة الشماليون بنظرهم لأبعد من ذلك، فلم يروا مشكلة في أن هذه الوحدة المتخيلة غير موجودة على أرض الواقع، فإذا كان الواقع غير مطابق للنظرية فلنغيره ليصبح كذلك. وهكذا فشل القادة الشماليون في أن يروا أن إصرارهم على وحدة الدين، واللغة، والتاريخ لوحدة القطر هو المهدد الرئيسي لتلك الوحدة، ولم يستشعروا خطورة التعويل على الوحدة الثقافية، في بلد متعدد الثقافات، وبالأخص في بلد حديث الإستقلال لم يتكون فيه الشعور الوطني بشكل كاف.
ولكن الفكر السياسي الجنوبي لم يكن يرى المسألة من هذه الزاوية، بل في واقع الأمر كان يراها من زاوية مغايرة تعطي نتائج جد مختلفة، فقد كانوا يرون "السودان دولة إفريقية عربية، لها شخصيتان متمايزتان وثقافتان، ومزاجان، إحداهما زنجية والأخرى عربية، وذلك أمر لا يرتبط بأي شكل بموضوع الدين واللغة. فلن يستطيع الإسلام أو المسيحية أن يوحد السودان، ولن تستطيع ذلك اللغة العربية، وهي أمور حدثت مبالغة في أهميتها في الآونة الأخيرة. فالوحدة في نطاق التعددية هي الحل لمشكلة الجنوب، وهو الحل الذي يمكن أن يتجسد في دستور فيدرالي." رسالة حزب سانو إلى السيد سر الختم الخليفة، رئيس وزراء حكومة أكتوبر بتاريخ 8 نوفمبر 1964
وهذه النظرة الباحثة عن الوحدة في التنوع رأيناها من قبل لدى الأب سترنينو لوهوري " إن الجنوب لا يكن أبداً نوايا سيئة تجاه الشمال. أن الجنوب فقط يطالب بإدارة شؤونه المحلية في إطار السودان الموحد، كما وأنه ليس لدى الجنوب نية للإنفصال عن الشمال… سينفصل الجنوب في أي وقت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة متى أراد الشمال ذلك، عن خلال سيطرة الشمال على الجنوب سياسيا وإجتماعياً وإقتصاديا" الأب سترنينو لوهوري مخاطباً البرلمان في 19 يونيو 1958 وسنراها فيما بعد لدى جون قرنق، وهي رؤيا رفضها القادة الشماليون أول الأمر وقاوموها بالقانون، وعندما إضطروا لقبولها كان كل ما يستطيعون تقديمه هو إحتفال لفظي بالتنوع، في وقت كانت هنالك مياه كثيرة قد جرت تحت الجسر.
بداية متعثرة للعلاقة
عند الإستقلال ولفترة طويلة بعده، لم يكن مفهوم القادة الشماليين والذي كان أسيراً لمفهوم الدولة القومية مستعداً لقبول فكرة الوحدة في التعدد. فنظروا لأي دعوى تتصل بذاتية الشعب الجنوبي، أو خصائصه الثقافية والعرقية، بإعتبارها شيء منفصل عن الخصائص الثقافية والعرقية لشعوب شمال السودان، بريبة شديدة. ومن هنا تكونت نظرة عامة ترفض أي بناء دستوري يعترف بهذه الذاتية، أو ذلك الخلاف. وهكذا رُفِضت مطالب الجنوبيين في النظام الفيدرالي. وقد جاء هذا الرفض على قمة عدد من التراكمات لتعثرات سادت العلاقة بين شطرى البلاد يوردها المؤلف بقوله صفحة 46 من الكتاب بقوله "ولكن العلاقة بين شمال البلاد وجنوبها سادها التعثر، والإرتباك، منذ بداية تلك الفترة. فقد تبخرت وعود مؤتمر جوبا بالمساواة في المواطنة والحقوق والواجبات والمعاملة. وتراكمت أخطاء الشماليين ، بدءاً بنقص أعداد الأعضاء الجنوبيين بالجمعية التشريعية من 15 إلى 13 عضواً، وفي رفض تمثيل الجنوبيين في المجلس التنفيذي، أو حتى قيام وزارة لشؤون الجنوب. ثم قام السادة الشماليون بتجاهل مطلب الجنوبيين من داخل الجمعية التشريعية ، وأيضاً من داخل لجنة الدستور، لإقامة نظام فيدرالي بين الشمال والجنوب، وزاد الشماليون على كل ذلك خطأً جسيماً آخر. فقد فشلت الأحزاب الشمالية في إشراك أبناء الجنوب في محادثات القاهرة …….. ولم تتم حتى دعوة بعض القادة الجنوبيين لحضور مراسم توقيع إتفاقية تقرير المصير في 12 فبراير 1953 ….. معطية الإنطباع بأن مستقبل السودان، وتقرير المصير، أمراً شمالياً بحتاً ولا دخل لأبناء الجنوب فيه" وهكذا بدأ التطور الدستوري السوداني بإغفال مطالب الجنوبين. يقول المؤلف ص 47 "وجاء قانون الحكم الذاتي خالياً من اية نصوص تعطي جنوب السودان أي وضع خاص، دعك من نظام الحكم الفيدرالي. وقد حذُفت المادة 100 من مشروع القانون، والتي كانت قد أعطت الحاكم العام صلاحيات خاصة تتعلق بالجنوب، شملت ضمان معاملة المديريات الجنوبية الثلاثة معاملة منصفة. وقد حلت محل هذه المادة فقرة فضفاضة تعطي الحاكم العام مسؤولية خاصة لضمان المعاملة المنصفة لكل مديريات السودان، وقد أثار حذف هذه المادة والإستعاضة عنها بهذه الفقرة غضب وإحباط الجنوبيين. وكان كل ما إشتمل عليه قانون الحكم الذاتي فيما يخص جنوب السودان هو منحهم مقعدين في مجلس الوزراء." ويظهر الإستعلاء الثقافي لدى القادة الشماليين آنذاك، والذي قادهم للتعامل غير الأمين مع الجنوبيين ببذل وعود فارغة، يظهر ذلك فيما ذكره الأستاذ محمد احمد محجوب، بأن قرار البرلمان السوداني في 19 ديسمبر 1955 حين طلب من الجمعية التأسيسية القادمة إعطاء النظام الفيدرالي الإعتبار الكافي، كان فقط لإرضاء الجنوبيين حتى يصوتوا للإستقلال. وهكذا بدأت الأمة حياتها بوعد لم تكن تنوي تحقيقه. لم يفت المؤلف أن يشير إلى أن الأستاذ محمود محمد طه كان هو السياسي الشمالي الوحيد الذي أخذ مطلب الجنوب مأخذ الجد وتبناه في كتابه الذي أصدره في ديسمبر 1955 بعنوان "أسس دستور السودان لقيام حكومة جمهورية فيدرالية ديمقراطية إشتراكية".
لم تكن سياسة السودنة التي إنتهجتها الحكومة الأولي تحت مظلة الحكم الذاتي مطمئنة للجنوبين، الذين لم ينالوا في مائدة المناصب المتاحة حتى ما يمكن الإشارة إليه بإعتباره فتاتاً. فلقد خصصت لجنة السودنة المكونة حصرياً من الشماليين، أقل من 1% من المناصب المتاحة للجنوبيين. يقول المؤلف ص 74 "عليه فلم يكن مستغرباً أن تندلع الحرب الأهلية في جنوب السودان وهو ما حدث في 18 أغسطس عام 1955 إثر قرار نقل أفراد الفرقة الإستوائية إلى الشمال، دون دراسة مسبقة لما يمكن أن تكون تداعيات هذا النقل. وقد وصفت لجنة التحقيق هذا النقل بالخطأ الفادح وشددت على أنه كان يجب إلغاؤه "
الحكم العسكري الأول وفرض الهوية قسرا
شهد الحكم العسكري الأول الإستجابة الفظة للفهم السائد آنذاك، بأن الوحدة لا يمكن أن تبني إلا عن طريق خلق هوية متجانسة مكونة من دين وثقافة واحدة، دون أن تفطن لأن ذلك لا يترك خياراً للجنوبيين إلا بالتباعد عن الشمال إذا أرادوا التمسك بذاتيتهم الثقافية. أضف لذلك أن الفروق العرقية لا يمكن تجاوزها إلا عن طريق إبادة الجنس. على أي حال فإنه يبدو أن النظام لم لم يكن بعيداً عن ذلك في بحثه غير العقلاني عن إيجاد وحدة ثقافية غير موجودة على أرض الواقع. يورد المؤلف في صفحة 82 من مؤلفه تصريحاً منسوباً إلى اللواء حسن بشير نصر يقول فيه "إذا كان لابد من ما ليس منه بد. فستضرم الحرائق في النبات والشجر والإنسان في الجنوب، ولن يبقى في تلك الأرجاء ديار، ولن تقوم بعدها لعقارب الأنيانيا السامة قائمة"
لم تكتفي السلطة آنذاك برفض النظام الفيدرالي بل إعتبرت الدعوة له جريمة تستوجب العقاب. وهكذا صرح السيد على بلدو مدير المديرية الإستوائية بأنه على "الجنوبيين الذين يريدون الفيدريشن أن يبحثوا عن شيء مفيد يفعلونه وإلا سيعرضون أنفسهم للعقاب" أنظر إلى الطريقة الأبوية التي يخاطب بها على بلدو الجنوبيين، وكأنهم صبية يعبثون. وهكذا تمت محاكمة الجنوبيين وسجنهم لمجرد المطالبة بالنظام الفيدرالي. وقد حررت ثورة أكتوبر السيد/ أزبوني منديري الذي وجدته سجيناً بسبب مطالبته بتطبيق الفيدرالية، وهو نظام ستتبناه بعد ذلك أول الأمر إتفاقية أديس أبابا، دون أن تذكره بالإسم، ثم دستور 98 ومن بعده دستور 2005 وكان دستور 1973 السلطوي هو أول دستور يتبنى المطالب المشروعة للجنوبيين، إلى أن قضى عليه وعليها جعفر نميري في عام 1983، وهو العام الذي بذر فيه بذور فناء نظامه. يقول المؤلف عن فترة الحكم العسكري الأول في صفحة 85 من مؤلفه " ورغم أن حكومة الفريق عبود لم تتبنى النظام الإسلام السياسي كفلسفة لحكم البلاد، أو تصدر قوانين إسلامية، إلا أنها تحركت بسرعة في إتجاه أسلمة وتعريب جنوب السودان بإعتبار أن المشكلة هي قضية تكامل ثقافي بين شطري البلاد سوف يحلها إعتناق الجنوبيين للديانة الإسلامية وتحدثهم للغة العربية . وقد قرر النظام الجديد في الخرطوم فرض الإثنين بالقوة في جنوب البلاد، كحل طويل المدى لمشكلة الجنوب. من هنا أخذ الحل العسكري في الجنوب بعداً إسلامياً عربياً، حتى مع غياب أي إدعاء أو مناداة بدولة إسلامية في الشمال. وقد رأت حكومة الفريق عبود في فرض الهوية الشمالية في الجنوب وسيلة للإندماج والتكامل بين شطري البلاد". ثم يشرح المؤلف سياسة الأسلمة بقوله في صفحة 86 من مؤلفه "لتطبيق برنامجها الإسلامي قامت الحكومة بطرد كل المنظمات الكنسية والتبشيرية، والبالغ عددها أكثر من 300 منظمة من الجنوب، وإغلاق الكنائس والمدارس التابعة لها. وصدر في عام 1962 قانون الجمعيات التبشيرية، والذي يتطلب من كل جمعية الحصول على إذن قبل ممارسة أي نوع من النشاط في جنوب السودان . تحدثت الحكومة أيضاً عن سودنة التبشير في الجنوب، ولكن يبدو أن ذلك الحديث كان لإمتصاص الغضب حول طرد المنظمات الكنسية الأجنبية من جنوب السودان. وقد تقرر أيضاً أن تكون عطلة نهاية الأسبوع هي يوم الجمعة بدلاً من يوم الأحد الذي كان العطلة منذ دخول الحكم الثنائي لجنوب السودان. كما بدأت الحكومة في مشروع متكامل بإرغام الجنوبيين على تغيير أسمائهم المسيحية، والمحلية، بأسماء عربية إسلامية، وفي فتح مدارس تعليم القرآن (المعروفة بالخلاوي) والمساجد (مع إغلاق الكنائس) وتدريس المواد الإسلامية في كل مدارس الجنوب . وقد تم تطبيق هذه الإجراءات بقوة السلاح التي منحتها الحكومة بدون قيود لحكام الجنوب العسكريين الجدد . وهكذا تزامن التصعيد العسكري لهزيمة التمرد مع تصعيد برنامج التكامل الثقافي بفرض اللغة العربية والديانة الإسلامية في كل أنحاء جنوب السودان"
لم تؤدي كل هذه الإجراءات إلى الغاية المرجوة بل تزايد التمرد، وتزايد نفوذ السياسيين الجنوبيين الداعين للفيدرالية، والذين كانوا يمارسون نشاطهم السياسي من أوغندا، بحيث إضطر الفريق عبود إلى مراجعة سياساته، فقام بتكوين لجنة ضمت خمسة عشرة من الشماليين وإثناعشر عضواً من الجنوبيين. ورغم هذا التواجد المحسوس للجنوبيين، إلا أن المرجعية التي وضعت للجنة، رفضت أن يكون السبب في النزاع المسلح التباين الثقافي، ولا العرقي، وتجاهلت أن طريقة معالجة ذلك التباين، والذي لم يكن أصلاً في حاجة لمعالجة، كان له القدح المعلى فيما وصل إليه الأمر، بالإضافة لمحدودية الصلاحيات الموضوعة للجنة، وكل هذا لم يكن يبشر بإمكانية التوصل لمقترحات تغير من السياسة المنفذة تغييراً ذا بال.
الجنوب ومسلسل سقوط الأنظمة
عموماً جاء تكوين اللجنة متأخراً جداً، وبعد أن كان زمان التغيير قد أزف. ولذلك فقد تحرك ثوار أكتوبر الذين أنهكتهم حرب أهلية لا أساس لها، وقلبوا الطاولة بأكملها على النظام الذي لم يعد هنالك سبباً لإستمراره. وهكذا بدأ مسلسل سقوط الأنظمة نتيجة لفشلها في معالجة مشكلة الجنوب. فلم يمض زمن طويل، حتى أسقط النميري الحكم الديمقراطي الثاني بإنقلاب عسكري، مستنداً على فشل ذلك النظام في إنهاء الحرب الأهلية، وما جرت إليه تلك الحرب من مشاكل إقتصادية وسياسية. وهو نفس السبب الذي سيسقط به نظام حكم الفرد الذي أقامه النميري بديلاً للنظام الديمقراطي. فرغم أن إستخدام نميري للطرح اليساري الذي حمله إلى السلطة في التوصل لحل لمشكلة الجنوب قد ساعده على البقاء في السلطة دون أي إنجاز آخر، لفترة طويلة، إلا ان طول فترة الحكم بدون خضوع للمحاسبة أفقد النميري القدرة على السماح بأي قدر من الحرية في أي جزء من القطر، فهدم الإتفاقية التي منحت حكمه إستقراراً نسبياً، وهدم معها أسباب بقاء النظام، فهوى حكمه نتيجة لإشتعال الحرب الأهلية مرة أخرى. ونواصل بإذن الله
سيحتاج هذا الكتاب لزمن أطول بكثير من الزمن الذي تيسر لي منذ أن أهداني الصديق العزيز نسخة منه، وحتى كتابه هذا المقال، لهضم كل ما جاء فيه من معلومات وأفكار وأطروحات، وهي أطروحات بالغة العمق كما تعودنا من صديقنا سلمان. على ضوء ذلك فهذا المقال لا يعدو أن يكون إنطباعاً أولياً قصدت أن اشارك القراء فيه بغرض التعريف بهذا المجهود الضخم، ودعوتهم لدراسة متعمقة له، ليس فقط بإعتباره توثيقاً مهماً لتاريخ مازال بعض من الذين حضروه يتشكل أمام أعينهم أحياء يمكن لهم أن يدلوا بدلوهم فيما شمله، أو لم يشمله، هذا السفر من وقائع، ولكن أيضاً لأن إستيعاب ما جاء في الكتاب يساهم في معالجة ما نعايشه الآن من مشكلات بعضها ناجم عما خلفه الإنفصال من مشاكل، ولكن أكثرها تسببت فيه نفس العوامل التي قادت إلى الإنفصال .
"إن لجنة الدستور قد أولت مطالب الجنوبيين للحكم الفيدرالي إعتبراً جاداً للغاية، وتوصلت إلى أن ذلك لن يكون مجدياً للسودان" قرار لجنة الدستور بخصوص مقترح النظام الفيدرالي لجنوب السودان، يونيو 1958.
قراءة في نتيجة إستفتاء جنوب السودان.
الكتاب هو ورقة إتهام للمكونات السياسية الرئيسية للسودان الشمالي، والتي ساهمت جميعاً في تسبيب إنفصال الجنوب ، حسبما إستخلص المؤلف من دراسته لكافة الظروف والملابسات التي قادت لذلك الإنفصال، والتي تتبعها المؤلف بدءً من مؤتمر جوبا 1947 وحتى التصويت فيما يشبه الإجماع على إنفصال الجنوب في مقتبل العشرية الثانية للألفية الثالثة. النتيجة التي توصل إليها المؤلف هي أن جميع القوى السياسية الفاعلة في شمال السودان، قد ساهمت بشكل او آخر، وبدرجات متفاوتة في المحصلة النهائية التي وصل إليها الأمر، وهي إنفصال الجنوب. بعضها بفشله في التعرف على جذور المشكلة، وبالتالي تقديم المعالجات التي يمكن لها أن تعالجها، وذلك بقصور الرؤيا حين غلّب الإيديولوجيا الضيقة ذات الطبيعة الوحدانية على واقع متعدد، والبعض الآخر بعدم الجرأة على الوقوف في وجه التيار العاطفي وغير العقلاني الذي قاد البلاد إلى تلك النتيجة الكارثية. وهذه النواقص، في رأي المؤلف، لم تقتصر على فصيل دون الفصائل الأخرى، بل شارك فيها الجميع بدرجات متفاوته، من موقع السلطة، إما بالفشل في إتخاذ القرار الصحيح، أو بالجرأة على إتخاذ القرار الخاطئ، حتى لم يعد هنالك مناصاً من الإنفصال.
حصل السودان على إستقلاله في زمن كانت فكرة الدولة القومية والتي تقوم على أن مشروعية الدولة تنبع من تأسيسها على حق الشعب المكون من قومية في تأسيس دولته، هي الفكرة المسيطرة على المناخ السياسي السوداني. لم يكن هنالك أصلاً صراع بين الإنتماء العربي، والإنتماء الأفريقي، على النحو الذي سنشاهده فيما بعد في السيتينات والسبعينات من القرن الماضي، وقد تم إنضمام السودان لجامعة الدول العربية كمسألة طبيعية، وغير مختلف عليها، فهي منظمة إقليمية عريقة سبق تأسيسها تأسيس الأمم المتحدة بعدة شهور، وكانت آنذاك تضم سبع دول فحسب، ولم يكن هنالك خيار أفريقي، لأنه كان علينا أن ننتظر حتى عام 1963 ليتم تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية والتي كان السودان من مؤسسيها.
رغم أن فكرة القومية العربية لم تستهوي القيادات السياسية السودانية في جانبها العملي، والمتصل بالدخول ضمن وحدة عربية مع الدول العربية الأخرى، خاصة وأن السودان كان حديث عهد برفض الوحدة مع مصر، إلا أن المناخ السياسي السوداني، والذي كان بشكل عام متأثراً بإنتصارات ناصر على النفوذ الإستعماري الأجنبي، جعل نطاق البحث عن مشروعية الدولة الجديدة ينحصر في الفكر القومي دون سواه. وهكذا عمد الساسة الشماليون إلى تأسيس مشروعية الدولة السودانية بشكل أو آخر على أساس قومي، لأن الدولة يجب ترتكز، في نظرهم، على وحدة الدين، واللغة، والتاريخ، فوحدة تلك العناصر وحدها هي التي يمكنها أن تخلق شعوراً وطنياً موحداً، وهو ما تحتاجه دولة حديثة الإستقلال تبحث عن هوية توحدها. لم يرمي الساسة الشماليون بنظرهم لأبعد من ذلك، فلم يروا مشكلة في أن هذه الوحدة المتخيلة غير موجودة على أرض الواقع، فإذا كان الواقع غير مطابق للنظرية فلنغيره ليصبح كذلك. وهكذا فشل القادة الشماليون في أن يروا أن إصرارهم على وحدة الدين، واللغة، والتاريخ لوحدة القطر هو المهدد الرئيسي لتلك الوحدة، ولم يستشعروا خطورة التعويل على الوحدة الثقافية، في بلد متعدد الثقافات، وبالأخص في بلد حديث الإستقلال لم يتكون فيه الشعور الوطني بشكل كاف.
عند الإستقلال ولفترة طويلة بعده، لم يكن مفهوم القادة الشماليين والذي كان أسيراً لمفهوم الدولة القومية مستعداً لقبول فكرة الوحدة في التعدد. فنظروا لأي دعوى تتصل بذاتية الشعب الجنوبي، أو خصائصه الثقافية والعرقية، بإعتبارها شيء منفصل عن الخصائص الثقافية والعرقية لشعوب شمال السودان، بريبة شديدة. ومن هنا تكونت نظرة عامة ترفض أي بناء دستوري يعترف بهذه الذاتية، أو ذلك الخلاف. وهكذا رُفِضت مطالب الجنوبيين في النظام الفيدرالي. وقد جاء هذا الرفض على قمة عدد من التراكمات لتعثرات سادت العلاقة بين شطرى البلاد يوردها المؤلف بقوله صفحة 46 من الكتاب بقوله "ولكن العلاقة بين شمال البلاد وجنوبها سادها التعثر، والإرتباك، منذ بداية تلك الفترة. فقد تبخرت وعود مؤتمر جوبا بالمساواة في المواطنة والحقوق والواجبات والمعاملة. وتراكمت أخطاء الشماليين ، بدءاً بنقص أعداد الأعضاء الجنوبيين بالجمعية التشريعية من 15 إلى 13 عضواً، وفي رفض تمثيل الجنوبيين في المجلس التنفيذي، أو حتى قيام وزارة لشؤون الجنوب. ثم قام السادة الشماليون بتجاهل مطلب الجنوبيين من داخل الجمعية التشريعية ، وأيضاً من داخل لجنة الدستور، لإقامة نظام فيدرالي بين الشمال والجنوب، وزاد الشماليون على كل ذلك خطأً جسيماً آخر. فقد فشلت الأحزاب الشمالية في إشراك أبناء الجنوب في محادثات القاهرة …….. ولم تتم حتى دعوة بعض القادة الجنوبيين لحضور مراسم توقيع إتفاقية تقرير المصير في 12 فبراير 1953 ….. معطية الإنطباع بأن مستقبل السودان، وتقرير المصير، أمراً شمالياً بحتاً ولا دخل لأبناء الجنوب فيه" وهكذا بدأ التطور الدستوري السوداني بإغفال مطالب الجنوبين. يقول المؤلف ص 47 "وجاء قانون الحكم الذاتي خالياً من اية نصوص تعطي جنوب السودان أي وضع خاص، دعك من نظام الحكم الفيدرالي. وقد حذُفت المادة 100 من مشروع القانون، والتي كانت قد أعطت الحاكم العام صلاحيات خاصة تتعلق بالجنوب، شملت ضمان معاملة المديريات الجنوبية الثلاثة معاملة منصفة. وقد حلت محل هذه المادة فقرة فضفاضة تعطي الحاكم العام مسؤولية خاصة لضمان المعاملة المنصفة لكل مديريات السودان، وقد أثار حذف هذه المادة والإستعاضة عنها بهذه الفقرة غضب وإحباط الجنوبيين. وكان كل ما إشتمل عليه قانون الحكم الذاتي فيما يخص جنوب السودان هو منحهم مقعدين في مجلس الوزراء." ويظهر الإستعلاء الثقافي لدى القادة الشماليين آنذاك، والذي قادهم للتعامل غير الأمين مع الجنوبيين ببذل وعود فارغة، يظهر ذلك فيما ذكره الأستاذ محمد احمد محجوب، بأن قرار البرلمان السوداني في 19 ديسمبر 1955 حين طلب من الجمعية التأسيسية القادمة إعطاء النظام الفيدرالي الإعتبار الكافي، كان فقط لإرضاء الجنوبيين حتى يصوتوا للإستقلال. وهكذا بدأت الأمة حياتها بوعد لم تكن تنوي تحقيقه. لم يفت المؤلف أن يشير إلى أن الأستاذ محمود محمد طه كان هو السياسي الشمالي الوحيد الذي أخذ مطلب الجنوب مأخذ الجد وتبناه في كتابه الذي أصدره في ديسمبر 1955 بعنوان "أسس دستور السودان لقيام حكومة جمهورية فيدرالية ديمقراطية إشتراكية".
شهد الحكم العسكري الأول الإستجابة الفظة للفهم السائد آنذاك، بأن الوحدة لا يمكن أن تبني إلا عن طريق خلق هوية متجانسة مكونة من دين وثقافة واحدة، دون أن تفطن لأن ذلك لا يترك خياراً للجنوبيين إلا بالتباعد عن الشمال إذا أرادوا التمسك بذاتيتهم الثقافية. أضف لذلك أن الفروق العرقية لا يمكن تجاوزها إلا عن طريق إبادة الجنس. على أي حال فإنه يبدو أن النظام لم لم يكن بعيداً عن ذلك في بحثه غير العقلاني عن إيجاد وحدة ثقافية غير موجودة على أرض الواقع. يورد المؤلف في صفحة 82 من مؤلفه تصريحاً منسوباً إلى اللواء حسن بشير نصر يقول فيه "إذا كان لابد من ما ليس منه بد. فستضرم الحرائق في النبات والشجر والإنسان في الجنوب، ولن يبقى في تلك الأرجاء ديار، ولن تقوم بعدها لعقارب الأنيانيا السامة قائمة"
لم تكتفي السلطة آنذاك برفض النظام الفيدرالي بل إعتبرت الدعوة له جريمة تستوجب العقاب. وهكذا صرح السيد على بلدو مدير المديرية الإستوائية بأنه على "الجنوبيين الذين يريدون الفيدريشن أن يبحثوا عن شيء مفيد يفعلونه وإلا سيعرضون أنفسهم للعقاب" أنظر إلى الطريقة الأبوية التي يخاطب بها على بلدو الجنوبيين، وكأنهم صبية يعبثون. وهكذا تمت محاكمة الجنوبيين وسجنهم لمجرد المطالبة بالنظام الفيدرالي. وقد حررت ثورة أكتوبر السيد/ أزبوني منديري الذي وجدته سجيناً بسبب مطالبته بتطبيق الفيدرالية، وهو نظام ستتبناه بعد ذلك أول الأمر إتفاقية أديس أبابا، دون أن تذكره بالإسم، ثم دستور 98 ومن بعده دستور 2005 وكان دستور 1973 السلطوي هو أول دستور يتبنى المطالب المشروعة للجنوبيين، إلى أن قضى عليه وعليها جعفر نميري في عام 1983، وهو العام الذي بذر فيه بذور فناء نظامه. يقول المؤلف عن فترة الحكم العسكري الأول في صفحة 85 من مؤلفه " ورغم أن حكومة الفريق عبود لم تتبنى النظام الإسلام السياسي كفلسفة لحكم البلاد، أو تصدر قوانين إسلامية، إلا أنها تحركت بسرعة في إتجاه أسلمة وتعريب جنوب السودان بإعتبار أن المشكلة هي قضية تكامل ثقافي بين شطري البلاد سوف يحلها إعتناق الجنوبيين للديانة الإسلامية وتحدثهم للغة العربية . وقد قرر النظام الجديد في الخرطوم فرض الإثنين بالقوة في جنوب البلاد، كحل طويل المدى لمشكلة الجنوب. من هنا أخذ الحل العسكري في الجنوب بعداً إسلامياً عربياً، حتى مع غياب أي إدعاء أو مناداة بدولة إسلامية في الشمال. وقد رأت حكومة الفريق عبود في فرض الهوية الشمالية في الجنوب وسيلة للإندماج والتكامل بين شطري البلاد". ثم يشرح المؤلف سياسة الأسلمة بقوله في صفحة 86 من مؤلفه "لتطبيق برنامجها الإسلامي قامت الحكومة بطرد كل المنظمات الكنسية والتبشيرية، والبالغ عددها أكثر من 300 منظمة من الجنوب، وإغلاق الكنائس والمدارس التابعة لها. وصدر في عام 1962 قانون الجمعيات التبشيرية، والذي يتطلب من كل جمعية الحصول على إذن قبل ممارسة أي نوع من النشاط في جنوب السودان . تحدثت الحكومة أيضاً عن سودنة التبشير في الجنوب، ولكن يبدو أن ذلك الحديث كان لإمتصاص الغضب حول طرد المنظمات الكنسية الأجنبية من جنوب السودان. وقد تقرر أيضاً أن تكون عطلة نهاية الأسبوع هي يوم الجمعة بدلاً من يوم الأحد الذي كان العطلة منذ دخول الحكم الثنائي لجنوب السودان. كما بدأت الحكومة في مشروع متكامل بإرغام الجنوبيين على تغيير أسمائهم المسيحية، والمحلية، بأسماء عربية إسلامية، وفي فتح مدارس تعليم القرآن (المعروفة بالخلاوي) والمساجد (مع إغلاق الكنائس) وتدريس المواد الإسلامية في كل مدارس الجنوب . وقد تم تطبيق هذه الإجراءات بقوة السلاح التي منحتها الحكومة بدون قيود لحكام الجنوب العسكريين الجدد . وهكذا تزامن التصعيد العسكري لهزيمة التمرد مع تصعيد برنامج التكامل الثقافي بفرض اللغة العربية والديانة الإسلامية في كل أنحاء جنوب السودان"
لم تؤدي كل هذه الإجراءات إلى الغاية المرجوة بل تزايد التمرد، وتزايد نفوذ السياسيين الجنوبيين الداعين للفيدرالية، والذين كانوا يمارسون نشاطهم السياسي من أوغندا، بحيث إضطر الفريق عبود إلى مراجعة سياساته، فقام بتكوين لجنة ضمت خمسة عشرة من الشماليين وإثناعشر عضواً من الجنوبيين. ورغم هذا التواجد المحسوس للجنوبيين، إلا أن المرجعية التي وضعت للجنة، رفضت أن يكون السبب في النزاع المسلح التباين الثقافي، ولا العرقي، وتجاهلت أن طريقة معالجة ذلك التباين، والذي لم يكن أصلاً في حاجة لمعالجة، كان له القدح المعلى فيما وصل إليه الأمر، بالإضافة لمحدودية الصلاحيات الموضوعة للجنة، وكل هذا لم يكن يبشر بإمكانية التوصل لمقترحات تغير من السياسة المنفذة تغييراً ذا بال.
عموماً جاء تكوين اللجنة متأخراً جداً، وبعد أن كان زمان التغيير قد أزف. ولذلك فقد تحرك ثوار أكتوبر الذين أنهكتهم حرب أهلية لا أساس لها، وقلبوا الطاولة بأكملها على النظام الذي لم يعد هنالك سبباً لإستمراره. وهكذا بدأ مسلسل سقوط الأنظمة نتيجة لفشلها في معالجة مشكلة الجنوب. فلم يمض زمن طويل، حتى أسقط النميري الحكم الديمقراطي الثاني بإنقلاب عسكري، مستنداً على فشل ذلك النظام في إنهاء الحرب الأهلية، وما جرت إليه تلك الحرب من مشاكل إقتصادية وسياسية. وهو نفس السبب الذي سيسقط به نظام حكم الفرد الذي أقامه النميري بديلاً للنظام الديمقراطي. فرغم أن إستخدام نميري للطرح اليساري الذي حمله إلى السلطة في التوصل لحل لمشكلة الجنوب قد ساعده على البقاء في السلطة دون أي إنجاز آخر، لفترة طويلة، إلا ان طول فترة الحكم بدون خضوع للمحاسبة أفقد النميري القدرة على السماح بأي قدر من الحرية في أي جزء من القطر، فهدم الإتفاقية التي منحت حكمه إستقراراً نسبياً، وهدم معها أسباب بقاء النظام، فهوى حكمه نتيجة لإشتعال الحرب الأهلية مرة أخرى. ونواصل بإذن الله





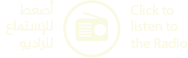
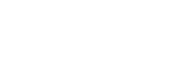




 and then
and then